|
||||||
| قضايا سياسية وأخبار مصرية وعربية وعالمية منتدى يختص بعرض كافة الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية في جميع أنحاء العالم |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
هيكل يكتب: مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان لغز رجل حكم مصر ثلاثين سنة.. آلاف الصور والحقيقة ضائعة.. هؤلاء الذين يظنون أنهم يعرفون مبارك هم فى واقع الأمر لا يعرفون عنه شيئاً .. (الحلقة الأولى)
 محمد حسنين هيكل ◄الشعب المصرى استطاع بالصبر والصمت - وإظهار السأم والملل أحينا - أن يتحمل الرجل وعندما لم يعد الصبر قادراً، ولا الصمت ممكناً، ولا الملل كافياً جاءت ثورة يناير! ◄إذا أخذنا الصورة الأكثر بهاء، باعتباره قائداً لما أطلق عليه وصف "الضربة الجوية" – إذن فكيف نزلت "الأسطورة" إلى تلك الصورة التى رأيناها بظهوره ممدداً على سرير طبى وراء جدران قفص فى محكمة جنايات مصرية، مبالغاً فى إظهار ضعفه، يرخى جفنه بالوهن. ملاحظة.. لم ألزم نفسى طوال هذه الصفحات بأوصاف للرئيس حسنى مبارك من نوع ما يرد على الألسنة والأقلام منذ أزيح عن قمة السلطة، وإنما استعملت الإشارات العادية طالما أن الرجل لم يُحاكم، ولم يُحكم عليه. ومع أن مبارك وصل إلى قاعة محكمة - ممدداً على سرير طبى دخل به إلى زنزانة حديدية - فإن التهم التى وجُهت إليه لم تكن هى التهم التى يلزم توجيهها، بل لعلها الأخيرة فيما يمكن أن يوجه إلى رئيس دولة ثار شعبه عليه، وأسقط حكمه وأزاحه. والمنطق فى محاكمة أى رئيس دولة أن تكون محاكمته على التصرفات التى أخل فيها بالتزامه الوطنى والسياسى والأخلاقى، وأساء بها إلى شعبه، فتلك هى التهم التى أدت للثورة عليه. أى أن محاكمة رئيس الدولة - أى رئيس وأى دولة - يجب أن تكون سياسية تثبت عليه - أو تنفى عنه - مسئولية الإخلال بعهده ووعده وشرعيته، مما استوجب الثورة عليه، أما بدون ذلك فإن اختصار التهم فى التصدى للمظاهرات - قلب للأوضاع يستعجل الخاتمة قبل المقدمة - والنتائج قبل الأسباب، ذلك أنه إذا لم يظهر خروج مبارك على العهد والوعد والشرعية، إذن فقد كان تصديه للمظاهرات ممارسة لسلطته فى استعمال الوسائل الكفيلة بحفظ الأمن العام للناس، والمحافظة على النظام العام للدولة، وعليه يصبح التجاوز فإصدار الأوامر أو تنفيذها - رغبة فى حسم سريع، ربما تغفره ضرورات أكبر منه، أو فى أسوأ الأحوال تزيداً فى استعمال السلطة قد تتشفع له مشروعية مقاصده! وكذلك فإنه بعد المحاكمة السياسية - وليس قبلها - يتسع المجال للمحاكمة الجنائية، ومعها القيد والقفص! بمعنى أن المحاكمة السياسية هى الأساس الضرورى للمحاكمة الجنائية لرئيس الدولة، لأنها التصديق القانونى على موجبات الثورة ضده، وحينئذ يصبح أمره بإطلاق النار على المتظاهرين جريمة يكون تكييفها القانونى إصراره على استمرار عدوانه على الحق العام، وإصراره على استمرار خرقه المستبد لعهده الدستورى مع الأمة! ومن هذا المنطق فإننى لم استعمل فى الإشارة إلى مبارك أوصافاً مثل المخلوع أو المطرود أو حتى السابق، وإنما استعملت على طول سياق هذه الصفحات ما هو عادى من الإشارات. وعلى أى حال فإنه من حق من يشاء - إذا شاء - أن ينزع إشارات استعملتها بمنطق ما قدمت، وأن يضع بدلها المخلوع والمطرود أو السابق! أردت بهذه الملاحظة أن أطرح مبكراً وجهة نظر لا أكثر، وحتى لا يأخذ على أحد تهمة أدب يتزيد، أو تمسك بأصول أسقطتها الدواعى! بدأت التفكير فى هذه الصفحات باعتبارها مقدمة لكتاب تصورت أن أجمع داخل غلاقه مجمل علاقتى بالرئيس حسنى مبارك، وقد كانت علاقة محدودة وفاترة، وفى كثير من الأحيان مشدودة ومتوترة، وربما كان أكثر ما فيها - طولاً وعرضاً - لقاء واحد تواصل لست ساعات كاملة، ما بين الثامنة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر يوم السبت 5 ديسمبر 1981 - أى بعد شهرين من بداية رئاسته - وأما الباقى فكان لقاءات عابرة، وأحاديث معظمها على التليفون، وكلها دون استثناء بمبادرة طيبة منه، لكن الواقع أن الحوار بيننا لم ينقطع، وكان صعباً أن ينقطع بطبائع الأمور طالما ظل الرجل مسيطراً على مصر، وظللت من جانبى مهتماً بالشأن الجارى فيها، وعليه فقد كتبت وتحدثت عن سياساته وتصرفاته، كما أنه من جانب رد بالتصريح أو بالتلميح، وبلسانه أو بلسان من اختار للتعبير عنه أو تطوع دون وكالة. وقد تراكم من ذلك كثير مكتوب مطبوع، أو مرئى مسموع، وفكرت أن أجعله سجلاً وافياً - بقدر الإمكان - لحوارات وطن فى زمن، ولعلاقة صحفى مع حاكم ومع سلطة فى الوطن وفى الزمن! لكنى رُحت أسأل نفسى عن الهدف من جمع هذا السجل، ثم ما هو النفع العام بعد جمعه؟! - وبداية فقد ورد على بالى أن تسجيل ما جرى فى حد ذاته قد يكون وسيلة إلى فهم مرحلة من التاريخ المصرى المعاصر مازالت تعيش فينا، ومازلنا نعيش فيها! - ثم ورد على بالى أن كثيراً من قضايا ما جرى مازالت مطروحة للحوار، وبالتالى فالتسجيل سند للوصل والاستمرار. - ثم ورد على بالى أن بعض الملامح والإشارات فى سياق ذلك الحوار ربما تكون مفيدة فى التعرف أكثر على لغز رجل حكم مصر، وأمسك بالقمة فيها ثلاثين سنة لم يتزحزح، وتغيرت فيها الدنيا، وظل هو حيث هو، لا يتأثر. وذلك لابد له من فحص ودرس! تركت خواطرى تطل على كل النواحى، ثم اكتشفت أن الاتجاهات تتفرع وتتمدد - لكن الطرق لا تصل إلى غاية يمكن اعتبارها نقطة تصل بالسؤال إلى جواب. وعُدت إلى ملفاتى وأوراقى، ومذكراتى وذكرياتى، وبرغم آثار كثيرة وجدتها، ومشاهد عادت إلىّ بأجوائها وتفاصيلها، فقد طالعنى من وسط الزحام سؤال آخر يصعب تفاديه - مجمله: - ماذا أعرف حقيقة وأكيداً عن هذا الرجل الذى لقيته قليلاً، واشتبكت معه - ومع نظامه - طويلاً؟! والأهم من ذلك: - ماذا يعرف غيرى حقيقة وأكيداً عن الرجل، وقد رأيت - ورأوا - صوراً له من مواقع وزوايا بلا عدد، لكنها جميعاً لم تكن كافية لتؤكد لنا اقتناعاً بالرجل، ولا حتى انطباعاً يسهل الاطمئنان إليه والتعرف عليه، أو الثقة فى قراره. بل لعل الصور وقد زادت على الحد، ضاعفت من حيرة الحائرين، أو على الأقل أرهقتهم، وأضعفت قدرة معظمهم على اختيار أرقبها صدقاً فى التعبير عنه، وفى تقييم شخصيته، وبالتالى فى الاطمئنان لفعله! وإذا أخذنا الصورة الأولى للرجل كما شاعت أول ظهوره، وهى تشبه بـالبقرة الضاحكة La vache qui rit - إذن فكيف استطاعت بقرة ضاحكة أن تحكم مصر ثلاثين سنة؟! وإذا أخذنا الصورة الأكثر بهاء، والتى قدمت الرجل إلى الساحة المصرية والعربية بعد حرب أكتوبر باعتباره قائداً لما أطلق عليه وصف الضربة الجوية - إذن فكيف تنازلت الأسطورة إلى تلك الصورة التى رأيناها فى المشهد الأخير له على الساحة، بظهوره ممدداً على سرير طبى وراء جدران قفص فى محكمة جنايات مصرية، مبالغاً فى إظهار ضعفه، يرخى جفنه بالوهن، ثم يعود إلى فتحه مرة ثانية يختلس نظرة بطرف عين إلى ما يجرى من حوله - ناسياً - أنه حتى الوهن له كبرياء من نوع ما، لأن إنسانية الإنسان ملك له فى جميع أحواله، واحترامه لهذه الإنسانية حق لا تستطيع سلطة أن تنزعه منه - إلا إذا تنازل عنه بالهوان، والوهن مختلف عن الهوان! وإذا أخذنا صورة الرجل كما حاول بنفسه وصف عصره، زاعماً أنه زمن الإنجاز الأعظم فى التاريخ المصرى منذ محمد على - إذن فكيف يمكن تفسير الأحوال التى ترك مصر عليها، وهى أحوال تفريط وانفراط للموارد والرجال، وتجريف كامل للثقافة والفكر، حتى إنه حين أراد أن ينفى عزمه على توريث حكمه لابنه، رد بحدة على أحد سائليه وهو أمير سعودى تواصل معه من قديم، قائلاً بالنص تقريباً: - يا راجل حرام عليك، ماذا أورث ابنى - أورثه خرابة؟! ولم يسأله سامعه متى وكيف تحولت مصر إلى خرابة حسب وصفه! وهل تولى حكمها وهى على هذا الحال؟ وإذا كان ذلك فماذا فعل لإعادة تعميرها طوال ثلاثين سنة؟ وهذه فترة تزيد مرتين عما أخذته بلاد مثل الصين والهند والملايو لكى تنهض وتتقدم! ثم إذا كان قد حقق ما لم يستطعه غيره منذ عصر محمد على - إذن فأين ذهب هذا الانجاز؟! - وكيف تحول - تحت نظامه إلى خرابة؟! - ثم لماذا كان هذا الجهد كله من أجل توريث خرابة خصوصاً أن الإلحاح عليه كان حقل الألغام الذى تفجر فى وسطه نظام الأب حطاماً وركاماً، مازال يتساقط حتى هذه اللحظة بعد قرابة سنة من بداية تصدعه وتهاويه! وكيف؟!! - وكيف؟!! - وكيف؟!! وهنا فإن التساؤل لا يعود على الصور، وإنما ينتقل إلى البحث عن الرجل ذاته! وعلى امتداد هذه الصفحات فقد حاولت البحث عن الرجل ذاته قبل النظر فى ألبوم صوره، وعُدت إلى ملفاتى وأوراقى، ومذكراتى وذكرياتى عن حسنى مبارك، ثم وقع بمحض مصادفة أننى لمحت قصاصة من صحيفة لا أعرف الآن بالتحديد ما دعانى إلى الاحتفاظ بها ثلاثين سنة، لكنى حين نزعتها من حيث كانت وسط المحفوظات - رُحت أقرؤها وأعيد قراءتها - مفتكراً!! وكانت القصاصة مقالاً منشوراً فى جريدة الواشنطن بوست فى يوم 7 أكتوبر 1981، وفى بداية المقال جملة توقفت عندها، وفى الغالب بنفس الشعور الذى جعلنى أحتفظ بها قبل ثلاثين سنة!! والجملة تبدأ بنقل "أن الأخبار من القاهرة بعد اغتيال الرئيس السادات تشير إلى أن الرجل الذى سوف يخلفه على رئاسة مصر هو نائبه حسنى مبارك - ثم تجىء جملة تقول بالنص: إنه حتى هؤلاء الذين يُقال إنهم يعرفون مبارك هم فى الحقيقة لا يعرفون عنه شيئاً. والآن بعد ثلاثين سنة وقفت أمام هذه الجملة، وشىء ما فى مكونها يوحى بأنها مفتاح المقال كله، لأننا بالفعل أمام رجل رأيناه كل يوم وكل ساعة، وسمعناه صباح مساء، واستعرضنا الملايين من صوره على امتداد ثلاثين سنة، لكننا لم نكن نعرفه ولا نزال!! وكان سؤالى التالى لنفسى: - إذا لم تكن للرجل صورة معتمدة تؤدى إلى تصور معقول عنه، فكيف أتفرغ شهورا لجمع ونشر ما سمعت منه مباشرة خلال مرات قليلة تقابلنا فيها، أو ما قلته له بطريق غير مباشر - أى بالحوار والكتابة والحديث ثلاثين سنة؟! وترددت، لكننى بإلحاح أن تلك ثلاثين سنة بأكملها من حياة وطن، وهى نفسها ثلاثين سنة من المتغيرات والتحولات فى الإقليم وفى العالم، قادنا فيها رجل لا نعرفه إلى مصائر لا نعرفها - فإن زمان هذا الرجل يصعب تجاوزه أو القفز عليه مهما كانت الأسباب، مع أن هناك أسباباً عديدة أبرزها أن التاريخ لم ينته بعد كما كتب بعض المتفائلين من الفلاسفة الجدد!! ثم كان أن توصلت إلى صيغة توفيق بين هذه الاعتبارات: من ناحية تصورت أن أحاول فى مقدمة مستفيضة لهذا الكتاب، أن أترك ما تحويه ملفاتى وأوراقى، ومذكراتى وذكرياتى - تنقل بعض الخطوط والأوان عن "حسنى مبارك" معترفا مقدما ومسبقا أن هذه المقدمة مهما استفاضت ليست كافة الإظهار لوحة تستوفى شروط المدرسة الكلاسيكية لفن الرسم، لكنها – كذلك خطر لى – قد تستطيع مقارنة بشروط مدرسة الرسم التعبيرى. بمعنى إنها قد تكون صورة لا تحاول تقليد مدرسة "ليوناردو دافنشى" أو "مايكل أنجلو" وحيا موصولا بالطبيعة، إنما تحاول تقليد مدرسة "رينوار" و"مانية" – تلمس موضوعها بمؤثرات أجوائه الإنسانية، وتشير إلى الطبع والشخصية مما يبلغ الحس ولا يطوله البصر. وراودنى على نحو ما أن الجميع – ربما – أخطأوا فى تصوير الرجل. لجأوا إلى الكاميرا تلتقط الصورة ومضا بالضوء، بينما كان يجب أن يلجـأوا إلى الفرشاة واللون رسما بالزيت، ثم إنهم كرروا الخطأ حين اختاروا المدرسة الكلاسيكية فى الفن، بينما كان يجب أن يلجأوا للمدرسة التأثيرية! وأظن أن ذلك ما حاولت بلمسات ألوان على مساحة ورق، تنزل عليها فرشاة زيت تشبعت به خفيفة وكثيفة، تؤمن بالظل أو بالفراغ، وتوحى بأكثر مما تصيح، وتعبر بقدر ما هو مستطاع فى زمن لم يعد فيه متسع لرقة "رينوار"، أو خيال "مانية". ولقد سألت نفسى كثيرا عن السبب الذى دعا الجميع إلى هذا التقصير فى البحث عن الرجل ذاته، وكيف تراكم التقصير فى التعرف على ثلاثين سنة؟! وكان التفسير متعدد الأسباب وكلها منطقية، لكنها تاهت فى الزحام: بعض الناس تلقفوه حين وجدوه ولم يتوقفوا أمام شخصيته وهو يقفز من المنصة إلى الرئاسة، فقد أخذهم هول ما وقع على المنصة، وتمسكوا بمن بقى بعده! وبعضهم أخذه الظاهر من الرئيس الجديد واستخف بما رأى، واعتبره وضعا مؤقتا لعبور أزمة، وبالتالى فالإطالة فى تحليله إضاعة للوقت! وبعض شدته الوقائع التى ظهر الرجل طرفا فى معمعانها، واستطاعت الصورة العامة للأحداث الكبر التى دهمت المنطقة أن تستوعب دوره ضمن الأدوار، ومع قيمة مصر فإن الجالس على قمتها التحف برايتها، وساعده الطامعون فى إرث الدور المصرى على تحويل هذه الراية إلى برقع يستر ملامح متغيرة للسياسة المصرية! وبعض ـ خصوصا من أجيال الشباب ـ نشأوا ولم يعرفوا رئيسا غيره، وبالتالى فإن أجيالا تعودت عليه، وتأقلمت بالطبع على وجوده. وبعضهم رغبة فى راحة البال تجاهل السؤال عن الرجل، واستعاض عنه بقبول جواب معبأ بصنعة إعلام يأتمر بالغلبة – غلبة السلطة – أو غلبة الثورة فى مصر، وكان لسوء الحظ إعلاما فقد تأثيره، وإن بقى هديره! ولعل.. ولعل.. وكلها علامات استفهام تحار فيها الظنون، لكن الواقع قبل وبعد أى شىء أن الرجل بقى على القمة فى مصر ثلاثين سنة! وأستأذن أن أؤكد وبوضوح أن هذه الصفحات وإن طالت عما توقعت – ليست قصة حياة، ولا هى سيرة رجل، وإنما هى لمحات قصرتها على ما رأيت بنفسى أو عرفت، وذلك هو عرى – واعتذارى – عن استعمال صيغة المتكلم فى بعض الفصول، وعذرى – واعتذارى أيضا – عن استعمال ألفاظ وعبارات بالعامية نقلتها كما سمعتها طلبا لدقة التعبير. وهنا أضيف أننى لم أسع إلى لقاء أحد ممن عملوا مع "مبارك" عن قرب أو عايشوه، فتلك مهمة غيرى إذا حاول كتابة سيرته أو تتبع دوره. ولقد راعنى – وأظنه راعى غيرى – أن كثيرين من هؤلاء الذين عملوا معه ومباشرة، كانوا أوائل من انقلبوا عليه، والمعنى هنا أن الرجل لم يرتبط بعلاقات إنسانية عميقة مع محيطه، ولا تواصل بولاءات متبادلة أو حميمة مع الذين اقتربوا منه وخالطوه، وإنما كانت علاقاته بهذه المحيط – على الأرجح – خدوشا على السطح لا يتبقى منها غير ندوب على الجلد تشحن وتزول بعد أيام أو أسابيع لا أكثر! ذلك هو الجزء الأول من هذا الكتاب! بقى الجزء الثانى، وذلك هو الجزء الأكبر فى الكتاب، وهو يشمل ما جمعت مما كتبت على الصفحات أو قلت على الشاشات، وكله مرتبط بقضايا العصر عرض وتحليلا – شرحا وتفصيلا، وظنى أنه وقد امتد على مساحة ثلاثين سنة، قد يعوض بالكلمات بعض ما لم تستطع أن تستوفيه الألوان! وأملى – ربما – أن شيئا فى هذا كله قد يرسل شعاعا يكشف ولو لمحة من تلك الفجوة المجهولة التى أشارت إليها جريدة "واشنطن بوست" منذ اليوم الأول لعصر "مبارك" حين قالت "إن الذين يظنون أنهم يعرفون الرجل هم فى الواقع لا يعرفون عنه شيئا". وذلك – مع الأسف صحيح – فلقد فاجأت هؤلاء العرافين بدايته، وفاجأتهم نهايته! يتبقى أن هناك سؤالا لا بد أن يصل إلى آذان الجميع: كيف استطاع هذا الرجل أن يجلس على رئاسة مصر ثلاثين سنة؟! ثم كيف استطاع شعب مصر أن يصبر ثلاثين سنة؟! وبالنسبة لـ"كيف" الأولى فالجواب على سؤالها: إنه حظه طالما استطاع البقاء! وأما "كيف" الثانية فجواب سؤالها: أنها مسئولية الشعب المصرى كله لأنه هو الآخر استطاع – استطاع بالصبر والصمت – وإظهار السأم والملل أحيانا – حتى جاءت ثورة 25 يناير 2011، وعندما لم يعد الصبر قادرا، ولا الصمت ممكنا، ولا الملل كافيا!
__________________
 آخر تعديل بواسطة prinofdar ، 17-01-2012 الساعة 05:51 PM |
|
#2
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
جزاك الله خيرا
__________________
 |
|
#4
|
|||
|
|||
|
هيكل!!!!!!!!!!!!!!!!
ترك نعيم القصر لينتقل لنعيم الأمير بكرة يطلع مذكرات يقول يها إنه المخطط الرئيسى للثورة كان فين أثناء شراكة إبنه لأولاد من يذمه ولماذا تأجلت حلقات شهادته عن مبارك على قناة الملعونة عدة سنوات طوال تواجد الرئيس المخلوع فى الحكم هو حرام لو تطهرنا من كل هؤلاء ؟ هو حرام لو بدأنا عهد جديد دون من دفعوا بالبلاد للتهلكة من أجل طموحاتهم السياسية ؟ خلونا مع شباب مصر الشرفاء شكرا جزيلا أستاذنا
__________________
الحمد لله |
|
#5
|
|||
|
|||
|
مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان (الحلقة الثانية) .. كيف تم اختيار (حسني مبارك) نائباً للرئيس .. ولماذا؟ بدأت متابعتى للرئيس «حسنى مبارك» ــ من بعيد بالمسافة، من قريب بالاهتمام ــ عندما ظهر على الساحة العامة لأول مرة قائدا لسلاح الطيران المصرى فى الظروف الصعبة التى تعاقبت بعد أحداث يونيو سنة 1967، ولم يخطر ببالى وقتها ــ لحظة واحدة ــ أن هذا الرجل سوف يحكم مصر ثلاثين سنة، ويفكر فى توريث حكمها بعده لابنه. وعندما أصبح «مبارك» رئيسا بعد اغتيال الرئيس «أنور السادات» فى أكتوبر 1981، فقد رحت حتى ونحن لانزال بعد فى سجن «طرة» (ضمن اعتقالات سبتمبر الشهيرة سنة 1981)، اذكِّر نفسى وغيرى بالمثل الفرنسى الشائع، الذى استخدمه الكاتب الفرنسى الشهير «أندريه موروا» عنوانا لإحدى رواياته، وهو أن «غير المتوقع يحدث دائما!!». ●●● وللأمانة فقد سمعت الفريق «محمد فوزى» (وزير الدفاع) يقدم لـ«مبارك» عند «جمال عبدالناصر» عندما رشحه له رئيسا للأركان فى سلاح الطيران أثناء حرب الاستنزاف، وكانت شهادة الفريق «محمد فوزى» تزكيه لما رُشح له، ثم كان أن أصبح الرجل بعد أن اختاره الرئيس «السادات» قائدا للسلاح ــ موضع اهتمام عام وواسع، لأن سلاح الطيران وقتها كان يجتاز عملية إعادة تنظيم مرهقة، وكانت هذه العملية تجرى بالتوافق مع قيام السلاح بدوره فى حرب الاستنزاف، وخلالها ــ تعاقب على قيادة الطيران خمسة من القادة هم: «صدقى محمود» و«مدكور أبوالعز»، و«مصطفى الحناوى»، و«على بغدادى»، ولم يستطع أيا من هؤلاء القادة إكمال مدته الطبيعية، وبالتالى فإن مجىء كل واحد منهم إلى قيادة الطيران كان حالة فوران لا يهدأ وسط أجواء مشحونة داخل واحد من أهم الأسلحة، فى لحظة من أشد اللحظات احتياجا إلى فعله!! ●●● وكان أول ما التقيت بـ«مبارك» ــ لقاء مصادفات عابرة، فقد كنت على موعد مع وزير الحربية وهو وقتها الفريق «محمد أحمد صادق» ــ وعندما دخلت مكتبه مارا بغرفة ياوره ــ كان بعض القادة فى انتظار لقاء «الوزير»، وكان بينهم «مبارك»، وأتذكره جالسا وفى يده حقيبة أوراق لم يتركها من يده، حين قام وسلم وقدَّم نفسه، وبالطبع فإننى صافحته باحترام، قائلا له فى عبارة مجاملة مما يرد على أول لقاء: «إن دوره من أهم الأدوار فى المرحلة المقبلة، و«البلد كله» ينتظر أداءه» ــ ورد هو: «إن شاء الله نكون عند حُسن ظن الجميع»، ودُعيت إلى مكتب الفريق «صادق»، ودخلت، وكانت مصادفة لقائى بـ«مبارك» ــ قبلها بثوانٍ ــ حاضرة فى ذهنى بالضرورة مع زيادة الاهتمام بالطيران وقائده، وبدأت فسألت الفريق «صادق» عن «مبارك» وهل يقدر؟!، وكان رده «أنه الضابط الأكثر استعدادا فى سلاح الطيران الآن بعد كل ما توالى على قيادة السلاح من تقلبات»، ولا أعرف لماذا أبديت بعض التساؤلات التى خطرت لى من متابعتى لـ«مبارك»، منذ ظهر على الساحة العامة، وكان مؤدى ما قلته يتصل بسؤال من فوق السطح (كما يقولون): كيف بقى الرجل قرب القمة فى السلاح خلال كل الصراعات والمتغيرات التى لحقت بقيادة سلاحه ــ وكيف استطاع أن يظل محتفظا بموقعه مع أربعة من القادة قبله، وكل واحد منهم أجرى من التغييرات والتنقلات ما أجرى؟!! زدت على هذه الملاحظة إضافة قلت فيها: أننى سمعت «حكايات» عن دوره فى حوادث جزيرة «آبا» قبل سنتين (وهى تمرد المهدية على نظام الرئيس السودانى «جعفر نميرى»، ونشوب صراع مسلح بين الفريقين سنة 1970)، وطبقا لـ«الحكايات» ومعها بعض الإشارات ــ فإن «مبارك» ذهب إلى السودان فى صحبة نائب الرئيس «أنور السادات»، لبحث ما يمكن أن تقوم به مصر لتهدئة موقف متفجر جنوب وادى النيل، ولتعزيز موقف «جعفر نميرى» فى تلك الظروف العربية الحرجة، وكانت أول توصية من بعثة «أنور السادات» وقتها هى الاستجابة لطلب الرئيس السودانى، بأن تقوم الطائرات المصرية المتمركزة أيامها فى السودان بضرب مواقع المهدية فى جزيرة «آبا» لمنع خروج قواتها إلى مجرى النيل، والوصول إلى العاصمة «المثلثة»، ودارت مناقشات فى القاهرة لدراسة توصية بعثة «السادات» فى «الخرطوم»، وكان القرار بعد بحث معمق ألا تشترك أية طائرات مصرية فى ضرب أى موقع، و«أنه لا يمكن لسلاح مصرى أن يسفك دما سودانيا مهما كانت الظروف». ثم حدث بعدها بأيام أن اغتيل زعيم المهدية السيد «الهادى المهدى». وراجت حكايات عن شحنة متفجرة وُضعت داخل سلة من ثمار المانجو وصلت إليه، وقيل ــ ضمن ما قيل عن عملية الاغتيال ــ أن اللواء «حسنى مبارك» (وهو الرجل الثانى فى بعثة «الخرطوم» مع «السادات») ــ لم يكن بعيدا عن خباياها، بل إن بعض وسائل الإعلام السودانية وقتها ــ وبعدها حين أصبح «مبارك» رئيسا ــ اتهمته مباشرة بأنه كان اليد الخفية التى دبرت لقتل الإمام «الهادى المهدى». وأشرت إلى ذلك كله بسرعة من اهتمام بالطيران وقتها وأحواله، وكان رد الفريق «صادق»: أنه سمع مثلما سمعت، لكنه لا يعرف أكثر. وأضاف «صادق»: «إذا كان «مبارك» قد دخل فى هذا الموضوع، فلابد أن الإلحاح والتدبير الأصلى كان من جانب «نميرى»، ثم إنه لابد أن «أنور السادات» كان يعلم» ــ ثم أضاف «صادق»: «بأن أول مزايا «مبارك» أنه مطيع لرؤسائه، ينفذ ما يطلبون، ولا يعترض على أمر لهم»، وانتقل الحديث بيننا إلى موضوع ما جئت من أجله لزيارته. ●●● وكانت المرة الثانية التى قابلت فيها «مبارك» فى تلك الفترة أثناء معارك أكتوبر 1973 ــ وكانت هى الأخرى لقاء مصادفات عابر، فقد ذهبت إلى المركز رقم 10 (وهو مركز القيادة العامة للمعركة)، وكنت هناك على موعد مع القائد العام الفريق «أحمد إسماعيل»، وكنا فى اليوم الخامس للحرب (12 أكتوبر)، وكان اللواء «مبارك» (قائد سلاح الطيران) هناك، وأقبل نحوى بخطى حثيثة، وعلى ملامحه اهتمام لافت، يسألنى: «كيف عرف الأهرام بتفاصيل المعركة التى جرت فوق قاعدة «المنصورة» ــ وكان هو موجودا فى القاعدة، وقابل طيارا إسرائيليا أسقطت طائرته، وجىء بالطيار الأسير لمقابلة قائد الطيران المصرى، ودار بينهما حوار، قال فيه «مبارك» للطيار الأسير: إنه تابع سربه أثناء الاشتباك، ولاحظ أخطاء وقع فيها، وسأله ماذا جرى لكم؟! ــ كنا نتصور الطيارين الإسرائيليين أكفأ، فهل تغيرتم؟!! ــ ورد الطيار الإسرائيلى قائلا: «لم نتغير يا سيدى، ولكن أنتم تغيرتم». وسألنى «مبارك» ــ وهو يمشى معى فى الممر المؤدى إلى مكتب الفريق «أحمد إسماعيل»، بإلحاح: «كيف عرفنا بهذه الحكاية؟! ــ مع أن المعركة جرت فى المساء أمس الأول، وهو نقل تفاصيلها على التليفون للرئيس «السادات» أمس، ثم قرأها كاملة فى «الأهرام»، وهو لم يحك إلا للرئيس وحده، فكيف «عرفنا» إذن؟!! ــ وقلت: «سيادة اللواء، أليست المسألة واضحة؟ ــ عرفنا من الرئيس نفسه»، ورد هو ودرجة الدهشة عنده تزيد: ــ من الرئيس نفسه؟ كما نقلتها له بالحرف؟! ــ ثم أبدى ملاحظة قال فيها: «ياه.. ده أنتم ناس جامدين قوى!!». وكنا قد وصلنا إلى مكتب «أحمد إسماعيل»، الذى ترك قاعة إدارة العمليات، وجاء إلى مكتبه قريبا منها يلقانى، ودخلنا إلى المكتب، وتركنا قائد الطيران ولا يزال يبدى دهشته من سرعة الاتصالات بين الرئيس وبين «الأهرام»!! وربما كان علىَّ أن أستغرب أكثر منه من هذا الاتصال المباشر بين قائد الطيران وبين رئيس الجمهورية عن غير طريق القائد العام، لكنى وقتها لم أستغرب، فقد تصورتها لهفة الرئيس على الاتصال المباشر بقواده دون مراعاة لتسلسل القيادة!! ●●● ومرت على هذه الأحاديث عدة سنوات، وقع فيها ما وقع وضمنه ذلك الصدام العنيف فى مايو 1971 ــ بين الرئيس «السادات» وبين ما سُمى وقتها بـ«مراكز القوى»، وفى أعقاب ذلك الصراع حدث إن الرئيس «السادات» ترك لى مجموعة أوراق كانت فى مكتب السيد «سامى شرف» (مدير مكتب الرئيس للمعلومات)، وكان الدكتور «أشرف مروان» الرجل الذى خلف «سامى شرف» فى مكتب المعلومات قد حملها إليه، وقال لى الرئيس «السادات» يومها وهو يشير إلى حقيبة أوراق أمامه «خذها ــ أنت تحب «الورق القديم»، وعندك الصبر لتقرأه، أما أنا فلا صبر عندى عليه!!». وبالفعل أخذت الحقيبة ــ لكنى لم أفحص محتوياتها إلا بعد أن تركت «الأهرام»، وتوافرت لى الفرصة كى أبحث وأراجع، خصوصا وقد بدأت فى إعداد كتاب جديد أقدمه للنشر الدولى فى «لندن» و«نيويورك»، وهو «الطريق إلى رمضان» The Road to Ramadan، ومع الغوص فى الأوراق ــ كانت الآثار الغارقة هناك!! كان السيد «سامى شرف» (سكرتير الرئيس للمعلومات، ثم وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية مع «عبدالناصر» ثم مع «السادات») قد جرى فى أسلوب عمله على أن يسجل بخط يده ما يسمع على التليفون، من أى مسئول فى الدولة، حتى لا يضيع من تفاصيله شىء عندما يعرضه على الرئيس، إذا كان فيه ما يتطلب العرض، وفى بعض المرات فإن «سامى شرف» كان يبعث بأصول ما كتبه بخط يده فى لحظته ــ لأهمية ما فيه ــ إلى الرئيس، ثم تعود إليه تلك الأصول وعليها تأشيرة برأى، أو إشارة برفض أو قبول، وأحيانا بعلامة استفهام أو تعجب. وداخل أحد الملفات المكدسة فى حقيبة السيد «سامى شرف» وجدت مذكرة مكتوبة بتاريخ أول أبريل سنة 1970 بخطه. وكانت المذكرة تسجيلا للنقط المهمة فى محادثة تليفونية أجراها السيد «أنور السادات» (نائب الرئيس الجديد منذ ديسمبر 1969) مع «سامى شرف» (سكرتير الرئيس للمعلومات)، والمكالمة من العاصمة السودانية حيث كان، ومعه رئيس أركان حرب الطيران اللواء «حسنى مبارك» لمساعدة الرئيس السودانى «جعفر النميرى» على مواجهة ذلك التمرد على سلطته بقيادة الإمام «الهادى المهدى» (زعيم الأنصار) ــ والذى كان متحصنا فى جزيرة «آبا»، يهدد بالخروج منها والزحف على مجرى النيل إلى الخرطوم. وكان الرئيس «نميرى» قد طلب ضرب مواقع «المهدى» فى جزيرة «آبا» بالطيران المصرى، وعندما رُفض طلبه فى القاهرة، لجأ الرئيس السودانى إلى السوفييت، وبالفعل فإن بعض خبرائهم قادوا ثلاث طائرات «ميج 17»، وحلَّقوا بها فوق جزيرة «آبا» فى مظاهرة تخويف حققت الهدف دون قصف، فقد شعر «المهدى» بقلق أنصاره فى الجزيرة، ومن أن يكون ظهور الطيران عملية استكشاف يعقبها سقوط القنابل، وهرول للخروج من «آبا» متجها إلى «كسلا» فى الشرق (وفى الغالب بقصد الوصول إلى أثيوبيا) ــ ثم حدث أن المخابرات السودانية استطاعت تحديد موقع «المهدى»، وهنا جرت محاولة اغتياله بسلة ملغومة وسط «هدية» من ثمار المانجو أُرسلت إليه ــ وفى تلك الظروف ثارت شكوك بأن «حسنى مبارك» كان اليد الخفية التى دبرت إرسال الهدية الملغومة، وظهرت أصداء لهذه الشكوك فى الصحف الموالية لـ«المهدى» فى «الخرطوم»!، وتلقى الوفد المصرى ــ وفيه «السادات» و«مبارك» ــ أمرا من القاهرة بمغادرة «الخرطوم»، والعودة فورا إلى القاهرة. وبالنسبة لى فقد تابعت بعثة «الخرطوم» ومهمتها، وأبديت رأيى برفض طلب «نميرى» أن يشترك الطيران المصرى فى ضرب جزيرة «آبا»، وكان إبدائى لرأيى رسميا، ثم ضاع الموضوع من شواغلى وسط الزحام، لأننى وقتها كنت متحملا بمنصب وزير الإعلام ــ إلى جانب تكليفى بوزارة الخارجية ــ وبمسئولية مباشرة عن التغطية السياسية والدبلوماسية والإعلامية لعملية كانت خطيرة وحيوية فى ذلك الوقت، وهى تحريك حائط الصواريخ المشهور إلى الجبهة، بكل ما يتطلبه وما يستدعيه ذلك من جهد، سواء فى المراكز الدبلوماسية للسياسة الدولية، أو فى دوائر الإعلام الواسع وبالذات مع وزارة الخارجية الأمريكية، ووزيرها فى ذلك الوقت «ويليام روجرز» (وكنت أعرفه من قبل لأنه كان عضوا فى مجلس إدارة جريدة «الواشنطن بوست») والآن فإنه المسئول الأول عن مبادرة تحمل اسمه (مبادرة «روجرز») لوقف إطلاق النار تسعين يوما (تتيح فرصة للسفير «جونار يارنج» ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كى يتوصل إلى حل على أساس قرار مجلس الأمن 242). وعندما سمحت لى الظروف فيما بعد أن أتفرغ للكتابة وللنشر، وتوفرت على دراسة ملفاتى وما تحتويه ــ إذا بى وجها لوجه أمام السر كاملا كما أسلفت!! ●●● ووسط ملفات مكدسة بالأوراق ظهرت أمامى تلك المذكرة بخط يد السيد «سامى شرف» كما سجلها أثناء مكالمة بينه وبين نائب الرئيس «أنور السادات» فى «الخرطوم». وسياق المذكرة واضح يبين أن «أنور السادات» يحكى على التليفون، و«سامى شرف» يلاحق ما يسمع ويسجله مكتوبا، وإن على عجل!! والمذكرة على ورقة رسمية لسكرتارية المعلومات فى رئاسة الجمهورية بتاريخ 1 أبريل 1970. ونصها الحرفى كما يلى: رئاسة الجمهورية العربية المتحدة سكرتارية الرئيس للمعلومات 1/4/1970 «خالد عباس» (1) ( ــ كانوا بيفكروا يعملوها إصلاح زراعى). و«النميرى» كان بيفكر أنه يعملها سجن. ــ موقف الرئيس معاهم رفع معنوياتهم جدا. ــ «نميرى» و«خالد» عايزين اجتماع سريع لرؤساء أ.ح (أركان حرب) الثلاثة لوضع خطة كاملة للتأمين، وتنفذ تلقائيا. ــ فيه 3 ملايين أنصارى فى «السودان». ــ «الخرطوم» الناس كلها كانت ماسكة العصايا من النصف، ما حدش وقف على رجليه إلا بعد مكالمة الرئيس، طلع «النميرى» حكى لهم المكالمة، فطلع الحزب الشيوعى اللى كان برضه ماسك العصايا من الوسط قبل المكالمة. ــ «مبارك» يحط تقرير عن سبت القنابل اللى بعتناه ــ سبب نجاح العملية ــ نتائجه قوية جدا (2). ــ الجيش أغلبه عساكر أنصار. ــ الإمام طلع من يومين بالعربيات على البحر الأحمر، وإحنا قاعدين عند «نميرى» جاء له خبر أن ضابط مسك الإمام (جريحا) فى عربية. ــ قال بنفكر (أنكم فى) مصر تاخدوه عندكم، قلت له عندى تفويض من الرئيس اللى إنت عايزه أعمله لك كله، إنما ما يخلص وبلاش وجع قلب. قام كلم «خالد حسن» وقال له خلصوا عليه وخلصت العملية». ●●● وكذلك بان السر أمامى كاملا كما أملاه «أنور السادات» بالتليفون على «سامى شرف»، لكن كل سر فى العادة له ذيول ــ فقد حدث بعد انتهاء معارك أكتوبر وحتى خلال أيامها الأخيرة أن أسبابا للخلاف شابت العلاقات بين الرئيس السادات وبينى»، وتركت «الأهرام»، وانقطعت لشهور صلاتى به، وعلى أى حال فقد كان هو مشغولا بعلاقته المستجدة مع «هنرى كيسنجر»، وكنت من جانبى مشغولا بالتحضير لكتاب جديد عن «العلاقات العربية ــ السوڤيتية» بعنوان “The Sphinx & The Commissar”، وناشره وقتها مؤسسة «أندريه دويتش» فى لندن ونيويورك، والحد الأقصى المسموح لى به حتى أقدم النص لا يزيد على تسعة شهور، وكذلك توقفت كل صلات بيننا، حتى جاء يوم 8 أكتوبر 1974، وإذا بالرئيس «السادات» يطلبنى بنفسه ويدعونى إلى لقاء معه «الآن» فى بيته (وهو شبه ملاصق لمكتبى بالجيزة) ــ مقترحا أن أمر عليه، ثم نذهب معا لحديث صريح ــ عن خلافنا ــ فى استراحة الرئاسة فى «الهرم». وفى كل الأحوال فإن «حسنى مبارك» لم يكن موجودا على شاشة الرادار فى اهتماماتى السياسية تلك الفترة. ●●● وليس هذا مجال تفاصيل هذا اللقاء مع الرئيس «السادات» وما بعده، لكن الاتصالات واللقاءات تكررت بيننا طوال شهور شتاء 1974 وإلى ربيع سنة 1975، حتى جاء يوم ــ فى شهر مارس من تلك السنة ــ قضينا فيه الصباح بأكمله معا فى استراحة القناطر ومن الساعة العاشرة إلى الساعة الثالثة بعد الظهر، وكان «مبارك» موجودا على مجرى الحوار، وليس فقط على شاشة الرادار!! والذى حدث أن الرئيس «السادات» سألنى فجأة وسط حديثنا الطويل ــ تحت شجرة «الفيكس» العريقة وسط حديقة الاستراحة فى القناطر ــ بما ملخصه: «أنه يجد نفسه حائرا بشأن منصب نائب الرئيس فى العهد الجديد بعد أكتوبر». واستطرد دون أن ينتظر منى ردا: «الحاج «حسين» ــ يقصد السيد «حسين الشافعى» (والذى يشغل بالفعل منصب نائب الرئيس) ــ لم يعد ينفعنى». ثم أضاف: «بصراحة جيل يوليو لم يعد يصلح، والدور الآن على جيل أكتوبر، ولابد أن يكون منه ومن قادته ــ اختيارى لنائب الرئيس الجديد!!». وأضاف الرئيس «السادات» ــ مرة أخرى ــ دون أن ينتظر ردا: «جيل أكتوبر فيه خمسة من القيادات، أولهم وهو «أحمد إسماعيل» توفى ــ والآن أمامى «الجمسى» (وكان مديرا للعمليات أثناء الحرب، وأصبح وزير الدفاع بعد «أحمد إسماعيل») ــ ثم «محمد على فهمى» (قائد الدفاع الجوى) ــ ثم «حسنى مبارك» (قائد الطيران)، ثم قائد البحرية (هكذا أشار إليه دون اسم)، وهو يقصد الفريق (فؤاد ذكرى)». وأضاف: «لابد أن يكون اختيارى ضمن واحد منهم». ورددت عليه بعفوية متسائلا: «ولماذا يحشر نفسه فى هذه الدائرة الصغيرة؟ ــ أقصد لماذا يتصور أن جيل أكتوبر هو فقط هؤلاء القادة العسكريون للمعركة؟!!». ورد بطريقته حين يريد إظهار الحسم: «أنت تعرف أن الرئيس فى هذا البلد لخمسين سنة قادمة لابد أن يكون عسكريا ــ وإذا كان كذلك، فقادة الحرب لهم أسبقية على غيرهم». وقلت والحوار تتسع دائرته: «إن أكتوبر كانت حرب كل الشعب، ثم إنك قلت لى الآن عن اعتزامك تكليف وزير الداخلية اللواء «ممدوح سالم» برئاسة الوزارة، وأخشى باختياره أنك تكون قد «بولست» (عن البوليس) الوزارة، ثم إنك بـ«مبارك» نائبا لك تكون قد «عسكرت» الرئاسة، وربما يصعب على الناس قبول الأمرين معا فى نفس الوقت». ورد قائلا: «أنه مندهش لترددى فى إدراك أهمية أن يكون رئيس مصر القادم عسكريا، ثم سألنى: ألست تعرف أن ذلك كان رأى «المعلم» يقصد «جمال عبدالناصر» أيضا؟!». وقلت: «إن الظروف ربما تغيرت، وليس لدىَّ تحيز ضد رئيس عسكرى، لكنه مع ضابط بوليس فى رئاسة الوزارة، وضابط طيار فى رئاسة الجمهورية ــ فإن صورة ما بعد الحرب سوف تبدو تركيزا على الضبط والربط لا تبرره الأحوال، وأما فيما يتعلق برأى «جمال عبدالناصر» فإن مسئوليات الحرب ــ وبالتالى منجزاتها ــ تغيرت كثيرا عندما التحق شباب المؤهلات بجيش المليون على الجبهة». وشعرت أنه متمسك برأيه، واقترحت عليه ــ بمنطق حجته: ــ ليكن ــ لماذا لم تفكر فى «الجمسى» مثلا؟!! ورد بسرعة: ــ لا، «الجمسى» لا يصلح للرئاسة ــ «الجمسى» فلاح وهو ليس من نحتاجه فى منصب نائب الرئيس الآن». وأدركت أن لديه مرشحا، وسألته فيمن يفكر، ورد على الفور على السؤال بسؤال كما كان يفعل أحيانا: «ما رأيك فى «حسنى مبارك»؟!». ــ وقلت: «إن اسمه لم يخطر ببالى، وإنما خطر ببالى مع إصراره على عسكرى من جيل أكتوبر، أن يكون نائبه الجديد إما «الجمسى» (وزير الدفاع الآن والذى كان مديرا للعمليات) أو «محمد على فهمى» (قائد الدفاع الجوى، وهو السلاح الذى قام بالدور الأكثر تأثيرا فى المعركة بحائط الصواريخ)، فإذا أراد غير هؤلاء، فقد يفكر فى واحد من قادة الجيوش». ورد: «لا، لا أحد من هؤلاء يصلح ــ «مبارك» أحسن منهم، خصوصا فى هذه الظروف!!». وسألته بالتسلسل المنطقى للحوار: أية ظروف بالتحديد؟!! وراح يشرح ويستطرد ويقاطع نفسه، ثم يعود إلى سياق ما يتكلم فيه، ثم يبتعد عنه، وكنت أشعر به كما لو أنه متردد فى الإفصاح الكامل عن فكره، وإن كانت بعض العبارات قد لفتت نظرى: ــ قوله مثلا: «أن هناك قيادات فى الجيش لم تفهم بعد سياسته فى «عملية السلام» ومقتضياتها». ــ وقوله مثلا: «أن هناك عناصر فى الجيش لاتزال مشايعة لـ«مراكز القوى» أو متعاطفة مع «سعد الشاذلى». ــ وقوله مثلا وهو يستدعى تجربة شاه إيران «محمد رضا بهلوى» الذى وصفه بأنه «سياسى عُقر»، وهو فى رأيه أوعى سياسى فى المنطقة، بحكم تجربة طويلة وراءه ــ استفاد كثيرا منها. وسألنى الرئيس «السادات» هنا: «ألا يلفت نظرك أن الشاه عين زوج شقيقته «فاطمى» (الجنرال «محمد فاطمى) قائدا للطيران؟! عنده حكمة فى هذا الاختيار، لأن الطيران يستطيع أن يتدخل بسرعة، وبقوة نيران كثيفة لمواجهة أى تمرد أو عصيان، أو حتى محاولة انقلاب». وسألته: «إذا كانت تلك نصيحة من شاه إيران؟!». وارتفع صوته محتجا يسأل: «هل هو فى حاجة إلى نصيحة يقولها له «الشاه»، أليس يكفينا أن نرى ما نرى، ونفهم منه ما نفهم، ثم سألنى مباشرة كمن يريد إفحام محاوره: «جرى لك إيه يا محمد؟!!». ولفت نظرى قول الرئيس «السادات»: «إن «مبارك» منوفى (وضحك مقاطعا نفسه: «مثلى»، ثم عاد إلى استكمال عبارته)، وله فى الطيران مجموعات بين الضباط مسيطرة على السلاح، ثم يضيف: و«التأمين» قضية مهمة فى المرحلة القادمة بكل ما فيها من تحولات قد لا يستوعبها كل الناس بالسرعة الواجبة». وسألته: «لكن «الشاه» عين زوج شقيقته قائدا للطيران، وليس نائبا لرئيس الدولة!! ــ و«مبارك» فيما أتصور لا خبرة له بشئون الحكم فى سياسة كل يوم، خصوصا ما يتعلق منها بمطالب الناس ومشكلاتهم، وسألته «ثم لماذا لا تتيح له فرصة التجربة وزيرا لإحدى وزارات الإنتاج أو الخدمات، حتى يتفهم الرجل أحوال الإدارة المدنية، وحتى يحتك ــ ولو من باب الإنصاف له ــ بمطالب الناس وحاجاتهم» ــ وكان رده: ــ «لا، لو فعلت ما تقترحه، فسوف أحرقه.. الإنجاز السريع فى الوزارات التنفيذية مسألة فى منتهى الصعوبة». ●●● ومرت فى ذهنى بارقة، فقد تذكرت ذلك التقرير الذى كتبه السيد «سامى شرف» بخط يده عن مكالمة تليفونية مع نائبه الرئيس «السادات» الذى كان فى الخرطوم سنة 1970، وضمن المكالمة ما يشيـــر التقرير عن محاولة اغتيال الإمام «الهادى» بسلة مانجو فى بطنها لغم!! وقلت للرئيس «السادات» وأنا لا أعرف بالضبط ما أفضى به الآن، وما أحجب مما قرأت فى مذكرة «سامى شرف»: ــ «ولكن «مبارك» دارت حوله إشاعات فى قضية اغتيال الإمام «الهادى»، وسوف تعود القضية كلها إلى التداول فى «الخرطوم» فور إعلان تعيينه نائبا للرئيس». ورد «السادات» على طريقته حين يريد «الإقناع» بما يتشكك فيه سامعه بأن: «مشكلتك (يا «محمد») أنك تصدق الإشاعات، ويظهر أن فترة الشهور التى انقطعت فيها عنى (أى منذ تركت «الأهرام» (فى فبراير 1974)) قد «أبعدتك» عن مصادر الأخبار الصحيحة». وقلت بأدب: «إن الأخبار الصحيحة متاحة فى كل مكان لمن يبحث عنها»، وتصور الرئيس «السادات» أنه بملاحظته ضايقنى، وإذا بابتسامة عريضة تملأ شفتيه مرة واحدة كما يفعل حين يريد إظهار سماحته، فأضاف بنبرته الودود المشهورة عنه: «المسألة أنك بغريزة الصحفى يشدك أى خبر مثير!!». وقلت: «أى خبر مثير؟! ــ أنت بنفسك رويت القصة كلها على التليفون، و«سامى شرف» سجلها بخطه لعرضها على «جمال عبدالناصر»، وما كتبه «سامى شرف» عندى فى أوراقى التى تفضلت وأعطيتها بنفسك لى!!». وبدا لى أنه فوجئ، وأول ما قاله فى التعبير عن مفاجأته «آه» ــ قالها خطفا، بمعنى الدهشة!! وكان سؤاله التالى بسرعة مستفسرا «وعندك الورقة التى كتبها «سامى»، ثم استطرد بأنه يريدها.. يريد أن يراها!! وقلت إن الورقة موجودة ولكنها ليست «هنا»، وذكَّرته بأننى استأذنته فى إخراج بعض أوراقى الخاصة بعيدا عن مصر، خوفا عليها من تربص صراعات السلطة التى لاحت نُذُرها بعد رحيل «جمال عبدالناصر». وقلت «أننى سوف أجىء له بها فى أول سفرة إلى أوروبا»، لكنى ذكَّرته بضرورة أن يتصور أن الأمريكان سجَّلوا مكالمته الأصلية مع «سامى»، وكذلك السوفييت، وربما أيضا إسرائيل، وإذن فهناك من يعرفون القصة، وربما يحتفظون بتسجيل كامل لحديثه مع «سامى»، بصرف النظر عن أية «ورقة مكتوبة»!! وأخذتنا بعد ذلك تطورات الحوادث، فلا الرئيس «السادات» عاد إلى طلب الورقة، ولا أنا عُدت بها معى من سفر!! ●●● لكن المسألة الأهم بعد هذا الحديث أننى خرجت من استراحة «القناطر» يومها مدركا عدة حقائق: 1ــ أن اختيار «مبارك» لمنصب نائب الرئيس لم يكن اختيارا «بسيطا» ــ بل مركبا ــ حكمته اعتبارات أخرى، فهو لم يكن اختيارا من بين الرجال الذين ظهروا فى حرب أكتوبر، على أساس دور متفوق على غيره فيها، وإنما كان اختيار «مبارك» شيئا آخر إلى جانب أكتوبر يقدمه ويزكيه. 2 ــ أن الرئيس «السادات» اختار رجلا يعرفه من قبل، وقد اختبر قدرته على الفعل، واستوثق منه. 3 ــ أن اختياره للرجل وقع وفى ذهنه قضية حيوية بالنسبة له ولسياساته ــ هى قضية تأمين النظام فى ظروف تحولات حساسة!! 4 ــ أن الرجل من قبل اختياره أظهر استعدادا عنده يجعله مهيأ للمضى «وراء حدود الواجب» على حد التعبير المشهور فى العسكرية البريطانية Going beyond the call of duty ــ أى المضى بتنفيذ الواجب حتى بالزيادة عليه بما ليس منه إذا قضت الأسباب!! آخر تعديل بواسطة prinofdar ، 17-01-2012 الساعة 02:52 PM |
|
#6
|
||||
|
||||
|
جزاك الله خيرا
__________________
 |
|
#7
|
|||
|
|||
|
هيكل!!!!!!!!!!!!!!!!
ترك نعيم القصر لينتقل لنعيم الأمير بكرة يطلع مذكرات يقول يها إنه المخطط الرئيسى للثورة كان فين أثناء شراكة إبنه لأولاد من يذمه ولماذا تأجلت حلقات شهادته عن مبارك على قناة الملعونة عدة سنوات طوال تواجد الرئيس المخلوع فى الحكم هو حرام لو تطهرنا من كل هؤلاء ؟ هو حرام لو بدأنا عهد جديد دون من دفعوا بالبلاد للتهلكة من أجل طموحاتهم السياسية ؟ خلونا مع شباب مصر الشرفاء شكرا جزيلا أستاذنا فلنعتبر هذه المشاركة هى تتر النهاية بعد كل حلقة فأرجوا عدم حذفها
__________________
الحمد لله |
|
#8
|
||||
|
||||
|
هيكل يكتب: مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان .. سؤال واحد وأجوبة گثيرة .. «أسامة الباز» يعرض لمفاتيح شخصية «مبارك»، و«منصور حسن» له رأى آخر.. رسالة من مبارك إلى المعتقلين فى طرة.. ( الحلقة الثالثة)
«عندما تلقيت دعوة إفطار مع الرئيس الجديد سألت الدكتور أسامة الباز والأستاذ منصور حسن: ماذا تعرفان عن الرجل لأنه فى ظنى شخصية أكثر تعقيداً من انطباع الناس عنه». وتدفقت مياه كثيرة بين ضفاف كل الأنهار، حتى جاء «خريف الغضب» سنة 1981، ووقع اغتيال الرئيس «السادات»، وأصبح نائبه «حسنى مبارك» مرشحا لخلافته، وتقرر الاستفتاء على رئاسته، وكانت اعتقالات سبتمبر الشهيرة سنة 1981 قد زجت فى السجن بأعداد من الساسة والنقابيين والكُتَّاب، وراح المعتقلون فى سجن «ملحق مزرعة طرة» وكنت بينهم يتابعون ما يجرى خارج أسوار السجن، لكن مصادر المعلومات كانت شحيحة ومتقطعة داخل هذه الأسوار!! وذات يوم فى تلك الفترة جاء إلى سجن «طرة» أحد مشاهير المحامين، وطلب لقاء ثلاثة من المعتقلين، كلا منهم على انفراد: «فؤاد سراج الدين» (باشا) و«فتحى رضوان» وكنت الثالث. وفى غرفة مأمور السجن وقتها، العقيد «محمود الغنام»، التقى المحامى بكل منا على انفراد، وكان طلبه أن يسلمه المعتقلون السياسيون فى «طرة» بيانا بتأييدهم لانتخاب «مبارك» رئيسا، والإيحاء فيما يطلب بأن ذلك يسهِّل خروجهم من السجن، دفعة مقدمة لحسن المقاصد! والمدهش أن الثلاثة وكل منهم مع الرسول على انفراد أبدوا نفس الرأى بما معناه: أنه لا يليق بسجين الرأى أن يؤيد مرشحا فى انتخابات الرئاسة، خصوصا إذا كان المرشح هو نفسه نائب الرئيس الآن، فذلك ليس مشرفا للسجين، وليس مشرفا للمرشح، لأن حرية الاختيار لا تُمارس من خلف القضبان، كما أن ممارسة الحرية من داخل زنزانة سجن لا تنفع صاحبها، ولا تنفع المقصود بها، لأنها معرَّضة للظنون والشبهات!! وتم الاستفتاء، وجرى انتخاب «مبارك»، وتلقيت بعدها بأيام رسالة عنه نقلها إلىَّ على تليفون مكتب مأمور السجن الدكتور «أسامة الباز» (وهو المستشار الأول للرئيس الجديد) مؤداها: «أنه تقرر الإفراج عن المعتقلين السياسيين على دفعات، وأن ذلك سوف يبدأ تنفيذه بعد مرور الأربعين (يوما) من وفاة الرئيس «السادات»، والرئيس الجديد يرجو أن نتحمل البقاء حيث نحن (فى طرة) حتى تنقضى الأربعون!!». وطلب «أسامة» أن أنقل ما أبلغه لى لمن أرى من رفاق السجن، وحين نقلت رسالة الليل إلى رفاق السجن فى «فسحة» الصبح، تفاوتت ردود أفعالهم. كان رأى الأستاذ «فتحى رضوان» مستثارا: «إنها خرافة تقاليد القرية»، و«منطق كبير العائلة» يحكم الرئيس الجديد طبقا لعقلية سلفه!!». وكان رأى «فؤاد سراج الدين» أكثر واقعية: «إن الرئيس الجديد ربما يخشى اتهامه بنقض قرارات سلفه، وأن إبلاغنا رسالة طمأنة مقصودة لنا ولغيرنا». وعلى أى حال قالها «فؤاد سراج الدين» موجها حديثه إلى «فتحى رضوان»: «لاحظ «أنهم» جميعا فى حالة صدمة، وكلهم فى موقف صعب، ويكفينا الآن أنهم قرروا الإفراج وأبلغونا به، وهذه إشارة واضحة». وواصل «فؤاد سراج الدين» وكلامه مازال موجَّها إلى «فتحى رضوان»: «وافرض أنهم أفرجوا عنا فورا، فماذا سنفعل، سوف يكون علينا أن ننتظر ما تتطور إليه الأمور، فإذا كان الانتظار، فلماذا لا يكون الانتظار هنا بدل أن نتوه بعد الخروج فى أحوال مضطربة كنا معزولين عنها خصوصا أننى أتوقع بعد هذه الرسالة أن تتحسن المعاملة، وأن تنتظم اتصالاتنا بالخارج، عندما يجيئون لنا بالصحف، ويُصرحون بالزيارات، وأيضا فإن أبواب الزنازين سوف لا تُغلق علينا طول النهار والليل كما هو حاصل، (باستثناء نصف ساعة للفسحة يوميا)، وهنا سوف يختلف مناخ السجن عما هو الآن». واحتج الأستاذ «مصطفى الشوربجى» (المحامى الشهير) قائلا ل«فؤاد سراج الدين»: «لا يا باشا، لا مساومة على حق الحرية». وكان رد «فؤاد سراج الدين»: عال.. لا تساوم، ولكن قل ماذا تستطيع أن تفعل؟!!». وكان استمرار الجدل عقيما، لأن المتنفذين خارج السجن كانت لهم الكلمة العليا فى شأن القابعين وراء أسواره!! وحين انقضت الأربعون بدأ الإفراج عنا، وارتأى «مبارك» أن يكون إطلاق سراحنا بعد لقاء معه فى قصر «العروبة»، وفى الطريق إلى هذا اللقاء عرضت على أصدقاء المجموعة الأولى من المُفرج عنهم أن يتولى أحدنا الحديث نيابة عنا، حتى نحافظ خلال اللقاء على إطار الاحترام اللازم للمناسبة ولأنفسنا، واقترحت أن يكون المتحدث باسمنا «فؤاد سراج الدين» (باشا) لأنه أكبرنا سنا، وأقدمنا عهدا بممارسة السياسة، ووافق الجميع. وكان عددنا (أى الدفعة الأولى من السياسيين المُفرج عنهم) حوالى الخمسة والعشرين، وحملتنا سيارة نقل كبيرة من سجن «طرة» إلى قصر «العروبة»، مارة على عنبر المستشفى المخصص للمعتقلين بالقصر العينى، حيث كان بعض من تقرر الإفراج عنهم – تحت العلاج فيه!! وصافحنا الرئيس الجديد واحدا واحدا، بينما وقف إلى جواره رئيس وزرائه الدكتور «فؤاد محيى الدين»، وعندما جلسنا حوله للحوار معه لاحظت أن الرئيس الجديد يبدى اهتماما بمعرفة رأيى، وقد وجَّه إلىّ الخطاب بوصفى «محمد بيه»، مضيفا: «تفضل» وأشرت إلى «فؤاد سراج الدين» الذى فوَّضناه بالحديث عنا، وكان ذلك السياسى المخضرم ممتازا فى عرضه وفى شرحه، وأظنه كان موفَّقا فيما تقتضيه المناسبة، ولكن «مبارك» التفت نحوى يسألنى إذا كنت أريد أن أضيف شيئا، وشكرته معتبرا أن «فؤاد» (باشا) قال كل ما يريد أينا قوله، (مع أن ذلك لم يمنع رغبة الكلام لدى آخرين وبالفعل تكلم بعضهم وحدث شىء مما تمنيت تجنبه، ومما يفعله الساسة أحيانا عند لقاء الحُكَّام، خصوصا إذا خطر لهم أن يقدموا أنفسهم تعريفا وربما تمهيدا)، ولزمت الصمت مؤثرا الاستماع!! ومضت أيام خمسة أيام بالعدد ثم تلقيت مكالمة من مكتب الرئيس يقول فيها سكرتيره الخاص وقتها (وأظنه السيد «جمال عبد العزيز»): «إن سيادة الرئيس يدعوك إلى الإفطار معه فى الساعة الثامنة صباح بعد غد، وقد اختار موعدا مبكرا لأن معلوماته أنك تستيقظ مبكرا، وهو فى ذلك «مثلك» يحب أن يبدأ النهار من أوله». أضاف محدثى: «إن «سيادة» الرئيس أمر بإبلاغى أننى المدعو على الإفطار وحدى» (أى أنه ليس هناك آخرون). وزاد محدثى بسؤال: «إذا كان يستطيع الاتصال بمكتبى ليحصل على رقم سيارتى حتى يسمح لها الأمن بالدخول إلى حرم البيت». عندما تلقيت دعوة الإفطار مع الرئيس الجديد، كان فى زيارتى (بمصادفة موفَّقة) صديقان قديمان، وهما الدكتور «أسامة الباز» والأستاذ «منصور حسن»، وكلاهما يعرف «مبارك» معرفة دقيقة، ف: «أسامة الباز» أقرب المستشارين إليه و«منصور حسن» زامله وزير دولة لشئون الرئاسة فى السنة الأخيرة لحكم «السادات»، وكان «مبارك» نائبا للرئيس، وبين الاثنين (نائب الرئيس ووزير الدولة لشئون الرئاسة) علاقات ملتبسة كثرت حولها الأقوال والروايات. وقلت للاثنين: «يظهر أننى سوف أقابل الرئيس الجديد بعد غد، وهذا رجل لم أره إلا فى مصادفات على عكس كليكما، فكل منكما عمل معه عن قرب، وتعرف على جوانب شخصيته». وأضفت: «إننى لا أريد علاقة وثيقة مع رئيس دولة آخر فى مصر، فقد أخذت نصيبى من هذه العلاقات مع «جمال عبد الناصر» من أول يوم إلى آخر يوم من دوره السياسى، ونفس الشىء طوال السنوات الأربع الأولى من رئاسة «أنور السادات» حتى اختلفنا فى إدارته السياسية لحرب أكتوبر، وأنا لم أعد أريد لا صداقات ولا عداوات مع رئيس دولة جديد فى مصر، وما أريده هو أن أحتفظ بحقى فى إبداء رأيى، ومن موقع الصحفى والكاتب وليس أقل أو أكثر!!». والمعنى أننى لا أريد علاقة خاصة، ولا أسعى إلى صدام، وإنما أريد ومن بعيد علاقات عادية، وهذه فرصة أن أسألكما: «كيف أتعامل مع «صاحبكما» فى هذه الحدود، خصوصا أننى كما قلت أعرف دواعى التزامه بسياسات لا أعتقد فى صحتها، ومن ناحية ثانية فإننى أراه أمامى شخصية أعقد بكثير من انطباع عام لدى الناس أشاع عنه نكتة «البقرة التى تضحك»، بينما هو فى ظنى شخصية أكثر تعقيدا». ورد «أسامة الباز» على الفور: «بأننى على صواب فى طرح حكاية «البقرة التى تضحك» جانبا، لأنها بالفعل تبسيط لشخصية مركبة». (لم أقل لهما أننى لمحت مبكرا بعض الجوانب المخفية فى سجل الرئيس الجديد (أى واقعة «الخرطوم»). واستطرد «أسامة» قائلا: «إنه يعرفنى جيدا، وقد كان فى هيئة مكتبى عندما كنت وزيرا للإعلام ووزيرا للخارجية، ثم اختار أن ينتقل معى إلى «الأهرام» بعد انتهاء مهمة وزارية (محددة المدة والهدف)، ثم ظل معى فى «الأهرام» حتى تركته بعد الخلاف مع الرئيس «السادات»، فعاد إلى الخارجية مستشارا فى مكتب وزيرها «إسماعيل فهمى». واستطرد «أسامة الباز»: «إننى عملت معك وعملت مع الرئيس «مبارك» أيضا منذ كلفنى الوزير «إسماعيل فهمى» لأكون مستشارا منتدبا من وزارة الخارجية معه كنائب للرئيس، خصوصا أن «السادات» راح يكلفه بمهام فى الإقليم وفى اتصالاتنا الخارجية، هكذا فإن لى معه الآن أكثر من اثنى عشر عاما». وأضاف «أسامة الباز»: وإذن فأنا أعرفك (يقصدنى) وأعرفه (يقصد الرئيس الجديد). ومضى «أسامة»: أكرر أنه من الصواب أنك استبعدت تماما حكاية «البقرة الضاحكة»!! وإذا طلبت رأيى بعد ذلك فلدى أولا ملاحظتان فى المنهج: أولاهما: «لا تتطرق فى الحديث معه إلى أى قضية فكرية أو نظرية، فهو ببساطة يجد صعوبة فى متابعة ذلك، لأنه أقرب إلى ما هو عملى منه إلى ما هو فكرى أو نظرى، وإذا جرت معه محاولة للتبسيط بالشرح، فإنه سوف يشرد من محدثه، ويتوقف عن المتابعة!!». والثانية: «أننى أعرف أسلوبك فى الحديث، تستطرد فيه أحيانا، ثم تذهب إلى خاطر يلوح أمامك، ثم تعود إلى سياقك الأصلى بعده. لكن «مبارك» لن يتابعك فى ذلك، كلِّمه فى موضوع واحد فى المرة الواحدة، ولا تدع الموضوعات تتشعب، وإلا فسوف تجد نفسك تتكلم بعيدا، وهو «ليس معك»! وأضاف «أسامة»: «تذكر أنه سمع كثيرا أكثر مما تتصور عنك من الرئيس «السادات»، وكثيرا ما سألنى: «كيف كانت صداقتك مع الرئيس «السادات» بهذا القُرب، ثم كان خلافكما إلى هذا الحد؟!! وذلك موضوع أثار فضوله، خصوصا أنه كان يعرف عمق صداقتك مع الرئيس «عبد الناصر»، وكانت درجة هذه الصداقة تبهره، وقد حكى لى أنه تابعك أثناء عملية تحريك حائط الصواريخ إلى الجبهة، عندما كنت وزيرا، وأنه أحس من كل ما تابعه، أنك تتصرف دون أن تنظر وراءك، وهذا يعنى أنك تقف على أرضية «جامدة جدا» (وتذكرت أن هذه هى المرة الثانية التى أسمع فيها نفس الوصف، مرة من «مبارك» مباشرة فى الطريق إلى مكتب «أحمد إسماعيل» (أثناء حرب أكتوبر 1973)، ومرة جديدة الآن نقلا عنه فى ظروف لم أكن أعرف بها!!)». ثم وصل «أسامة» ثانيا إلى ملاحظتين فى الأسلوب إضافيتين: «هو رجل يعرف «قوة السلطة» حيث تكون، وهذا مفتاح ثالث لشخصيته، ومفتاح آخر قدرته على الاحتفاظ لنفسه بنواياه.. ولذلك أرجوك ألا تحاول استكشاف فكره، لأنك سوف تستثير حذره، والحذر غريزة عنده مرتبطة بفهمه لقوة السلطة!!». والتفَتُّ ناحية «منصور حسن» وكان يتابع الحديث باهتمام وبابتسامة زاد اتساعها عندما جاء الدور عليه أسأله كان رد «منصور حسن»: «إنه لن يقول لى شيئا، وإنما يؤثر أن يتركنى أكتشف بنفسى». وأضاف «منصور حسن» :«كل ما سوف تسمعه لن يهيئك لما سوف تراه، والأفضل أن ترى بنفسك، وبعدها فأنا الذى سوف يسمع منك!».
__________________
 آخر تعديل بواسطة راغب السيد رويه ، 22-01-2012 الساعة 03:57 AM |
|
#9
|
||||
|
||||
|
اليوم السابع تقرأ الحلقة الرابعة من كتاب "هيكل" فى دار الشروق.. لقاء الست ساعات.. رأى مبارك فى الصحافة والصحفيين.. مبارك يريد أن يعرف أكثر عن علاقة عبد الناصر والسادات
◄ يعرض الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى الحلقة الرابعة من سلسلة كتاباته التى تصدر عن دار الشروق أولى لقاءاته مع الرئيس السابق حسنى مبارك فى منزله، وفيه يتحدث هيكل عن شعوره بهذا اللقاء. فيقول، كان اللقاء مع «مبارك» وديا، ولا أستطيع أن أقول حميما، ولم تكن الحميمية متصورة بعد متابعتى له من بعيد، منذ ظهر أمامى فى «الخرطوم» ثم نائبا للرئيس فى ظروف تشابكت فيها العلاقات بينى وبين الرئيس «السادات» ما بين سنة 1974 وسنة 1975، ثم انقطعت فى نفس الظروف التى أصبح هو فيها نائبا للرئيس، ومسئولا عن الأمن والتأمين، ثم رئيسا للدولة فى ظروف عاصفة!! وصباح يوم موعدنا السبت 5 من ديسمبر وصلت إلى بيته فى الموعد المحدد وعبرت باب البيت من ردهة إلى صالون فى صحبة ضابط برتبة عميد، ولم أنتظر أكثر من دقيقة فى الصالون، حتى دخل «مبارك» مادا يده ومرحّبا بابتسامة طيبة وملامح تعكس حيوية شباب وطاقة!! وقال على الفور وهو ما زال واقفا: «لابد أنك جائع فأنا أعرف أنك تستيقظ مبكرا». وقلت: «بصراحة سيادة الرئيس إننى أفطرت فعلا، ولكنى سوف أجلس معك وأنت تتناول إفطارك»، وضحك قائلا: الحقيقة أننى أيضا أكلت شيئا خفيفا، وقلت له: «إذن فلا داعى لإضاعة وقت على مائدة الإفطار، فلدىَّ الكثير أريد أن أسمعه منك»، وأبدى موافقته بعد تكرار سؤاله عما إذا كنت لا أريد أن آكل أى شىء مما جهزوه لنا، وكررت الشكر، وقال: إذن نطلب فنجانين من القهوة ونجلس. قدم لى الرئيس «حسنى مبارك» دون أن يقصد من ناحية، ودون أن أقصد أيضا مفتاحا لم أتوقعه من مفاتيح شخصيته، ولسوء الحظ فإن ما قدَّمه لى فات علىَّ فى وقته، مع أنه استوقفنى فعلَّقت عليه!! قلت للرئيس «مبارك» فور أن جلسنا: «إننى فكرت بالأمس أن أطلب مكتبه، راجيا تغيير موعدنا، لأنى قرأت فى الصحف عن مشاورات يجريها لتعديل وزارى أعلن عنه، وقد خطر لى أن موعدى معه اليوم قد يُحدث التباسا وخلطا لا ضرورة له، بين لقاءاته فى إطار التعديل الوزارى، وبين لقاءاته العادية الأخرى وضمنها موعدى معه، وأول الضحايا فى هذا الخلط والالتباس سوف يكون فريق الصحفيين الذين يغطون أخبار رئاسة الجمهورية». ورد «مبارك» وهو يبتسم بومضة شقاوة فى عينيه: وماذا يضايقك فى ذلك.. «اتركهم يغلطوا!». ◄ ويوضح الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل رؤية مبارك للصحافة والصحفيين خلال تبادل أطراف الحديث مع الرئيس السابق، فيقول هيكل. لم يتضح لى قصده، وسألته، وجاء رده بما لم أفهمه فى البداية حين قال (يقصد الصحفيين): دول عالم «لَبَطْ»، وأبديت أننى لم أفهم المعنى، واستنكر بُطء فهمى فقال: «لا تعرف معنى «لَبَطْ» هل أنت «خواجة»؟!، وأكدت له أننى أبعد ما أكون، وراح يشرح معنى «لَبَطْ»، ثم واصل شرحه: «اتركهم يغلطوا» حتى يتأكد الناس أنهم لا يعرفون شيئا». ومرة ثانية لم يتضح لى قصده، ومرة ثانية سألته، ورد، وعلى شفتيه ما بدا لى «ابتسامة من نوع ما»: «إن الصحفيين يدَّعون أنهم يعرفون كل شىء، وأنهم «فالحين قوى»، والأفضل أن ينكشفوا أمام الناس على حقيقتهم، وأنهم «هجاصين» لا يعرفون شيئا». قلت: ولكن سيادة الرئيس هذه صحافتك، أقصد «صحافة البلد»، ومن المفيد أن تحتفظ لها بمصداقيتها، ولا بأس هنا من جهد لإبقاء الصحفيين على صلة بالأخبار ومصادرها. ورد بقوله: «الدكتور «فؤاد» (يقصد رئيس وزارته وقتها «فؤاد محيى الدين») يقابل الصحفيين باستمرار، ويطلعهم على الحقائق، لكن بلا فائدة، هم «يخبطوا على مزاجهم» ولا يسألون أحدا!». وقلت: «إنه ليس هناك صحفى يحترم نفسه تصل إليه أخبار حقيقية ويتردد فى نشرها». وظل على رأيه: «المسألة أنهم لا ينشرون، إما أن لهم مصالح خاصة، وإما أنهم لا يفهمون». وأحس أننى لم أقتنع، وتفضَّل بما ظن أنه مجاملة قائلا:«محمد بيه» أنت تقيس الصحفيين الحاليين بتجربة زمن مضى، ليس هناك صحفى الآن له علاقة خاصة بالرئيس (وكانت الإشارة واضحة)، وقلت إن «جمال عبدالناصر» كان متصلا بكثيرين من الصحفيين، ثم إن هذا لا يمنع قيام صداقة مع أحدهم بالذات، ولكن المهم أن يكون أصبع رئيس الدولة على نبض الرأى العام طول الوقت». وانتقل والدهشة عندى تزيد قائلا:«على فكرة نحن كنا نتصور أنك تجلس على حِجْر الرئيس الرئيس «جمال»، لكنه ظهر أن الرئيس «جمال» كان هو الذى يجلس على حِجْرك، واستطرد: لم أكن أعرف أن العلاقة بينكما إلى هذا الحد حتى شرحها لى (أشار إلى اسم الأستاذ «أنيس منصور)»!! ◄ ويشير هيكل إلى دهشته من حديث الرئيس السابق حول العلاقة بين الكاتب الكبير والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فيستطرد هيكل، قائلاً: استهولت ما سمعت، وبان ذلك على ملامحى، وربما فى نبرة صوتى حين قلت له:«سيادة الرئيس أرجوك لا تكرر مثل هذا الكلام أمام أحد، ولا حتى أمام نفسك، أولا لأنه ليس صحيحا، وثانيا لأنه يسىء إلى رجل كان وسوف يظل فى اعتقادى واعتقاد كثيرين فى مصر وفى الإقليم وفى العالم قائدا ورمزا لمرحلة «مهمة» فى التاريخ العربى». أضفت: «فيما يتعلق بى فقد كان يمكن أن يرضى أوهامى أننى كنت «كل شىء» وقت «جمال عبد الناصر»، ولكن ذلك غير صحيح، لأن «جمال عبد الناصر» كان هو «جمال عبد الناصر»، وقد أسعدنى ولا يزال أننى كنت صديقا له وقريبا منه ومتابعا لدوره وهو يصنع للأمة كلها تاريخا يمثل على الأقل لحظة عز وقوة لها فى عالمها وعصرها، وأنا أقول ذلك بعيون مفتوحة، مدركا أن تجربة «عبد الناصر» كانت إنسانية قابلة للخطأ أحيانا كما للصواب، كما أنها ليست أسطورية معصومة بالقداسة، لأن ذلك غير إنسانى، وهذه هى الحقيقة»!. وقاطعنى: «أنا أعرف كم كان الرئيس «جمال» شخصية عظيمة، وما قلته لك كان كلام (أعاد الإشارة إلى اسم «أنيس منصور»!)، وهو لم يقله لى فقط، وإنما نشره أيضا، أما أنا فلم أقل من عندى إلا ما قلته أنت فى وصف علاقتك به، من أنك كنت صديقا له وقريبا منه هذا ما قصدته، وقصدت أنك كنت تعرف كل شىء، بينما الصحفيون الآن لا يعرفون». وقلت: «إن علاقته هو (أى «مبارك») بالصحفيين فى عهده اختياره، وله أن يوصفها كما يرى، لكنى أتمنى لو استطاع أن يسهِّل على الصحافة أن تعرف أكثر، لأن تلك مصلحة الجميع، وأولهم هو شخصيا». وظل على رأيه لم يغيره، وأكثر من ذلك فإن رده علىَّ كان بقوله: «أنه إذا عرف الصحفيون أكثر، فسوف يتلاعبون به». وقلت فى شبه احتجاج: «سيادة الرئيس أنت تسىء الظن بإعلامك، وأنا أعرف بعضا من شيوخ المهنة وشبابها، وأثق أنهم لن يتلاعبوا فى أخبار، فضلا عن أسرار». وشرحت لمحات عن مهنة الصحافة فى مصر وتاريخها ورجالها، ومع أنى أسهبت إلى حد ما فى الحديث عن تاريخ الصحافة المصرية، فقد أحسست أنه يتابع، وكانت له عدة أسئلة واستفسارات عن الأشخاص وعن الوقائع. ثم آثرت أن أنتقل من هذا الموضوع إلى غيره مما يعنينى فى أول لقاء مع رئيس الدولة الجديد فى مصر، وفى ظروف عاصفة يندر أن يكون لها مثيل هبت على مصر نارا ودما!! ◄ ويوضح هيكل، أن الحوار انتقل بينه وبين الرئيس مبارك إلى مرحلة تبادل الأدوار.. بمعنى أدق أن الكاتب الكبير طلب الاستماع إلى مبارك، إلا أن الرئيس السابق طلب أن يستمع هو إلى هيكل فى هذه المرة، باعتبار أن الرئيس السابق مازال فى مرحلة استكشاف.. فيقول هيكل. وكذلك عُدت بالحديث إلى مدخله الطبيعى، فقلت للرئيس: إننى متشوق إلى سماعه. ورد قائلاً: ولكن أنا أريد أن أسمعك هذه المرة وأن أسألك، وفى المرة القادمة أنت تسألنى أضاف بتواضع أنه يعتبر نفسه هذه الفترة فى «مهمة استكشاف»، يتعرف فيها على «الجو» الذى يتعين عليه العمل فيه!». وأضاف: «أنا طلبت منك أن تتكلم يوم جئت إلى قصر «العروبة» بعد الإفراج عنكم، ولكنك لم تتكلم». وقلت: «إننى اعتذرت لأن اتفاقنا قبل المجىء إلى عنده كان أن يتكلم واحد منا بالنيابة عنا جميعا، وقد اخترنا «فؤاد سراج الدين» لأنه أكبرنا سنا، وأسبقنا جميعا إلى ممارسة العمل السياسى». وقاطعنى بسؤال: هل عرفت «سراج الدين» وأنتم فى «طرة»؟!! وقلت: إننى أعرفه من قبل ثورة 1952، وحين كان سكرتيرا عاما لحزب الوفد ووزيرا للداخلية، وقتها (فى أواخر العشرينيات من عمرى) كنت رئيسا لتحرير «آخر ساعة»، ومديرا لتحرير «أخبار اليوم»، وعلى علاقة بمعظم الساسة فى مصر، وكان «فؤاد سراج الدين» من أبرزهم، ولم تتغير علاقتى به أو بهم، بل توثقت مع مرور الأيام، وحتى بعد ثورة يوليو. وقاطعنى «مبارك» بسؤال: هل كان الرئيس «عبد الناصر» يعرف ذلك ويقبل به؟!! قلت له: «جمال عبد الناصر» كان يحب «مصطفى النحاس» مثلا (رئيس الوفد) ويحترمه، وكان يرى مزايا كثيرة ل«فؤاد سراج الدين»، ويعتبره سياسيا ذكيا مجربا، حتى وإن اختلف معه». وتوقف «مبارك» للحظة مترددا ثم سأل: ولكن ألم يحدث أن الرئيس «جمال» اعتقل «النحاس» (باشا)؟!! وقلت: بالمعنى الحقيقى لم يعتقله، وإنما أصدر قرارا بتحديد إقامته فى بيته، وكان ذلك سنة 1955، وفى الظروف الخطرة على الطريق إلى حرب السويس، وكانت المعلومات وقتها أن الإنجليز يبحثون عن حكومة بديلة لنظام 23 يوليو، وخشى «جمال عبد الناصر» أن يقوم أحد بتوريط «النحاس» (باشا) فى حديث عن حكومة بديلة، خصوصا وأن المعلومات وقتها كانت أن المخابرات البريطانية m.i.6 تقترح إما «النحاس» (باشا)، وإما اللواء «محمد نجيب» لرئاسة حكومة يستطيعون الاتفاق معها، وأظنه أراد حماية «النحاس» (باشا) أكثر مما أراد الإساءة إليه، وأنا أعرف أن الأسلوب غريب فلا أحد يستطيع حماية رجل يحرص عليه بتحديد إقامته فى بيته، لكن «جمال عبد الناصر» وفى الكلام معى أشار إلى هؤلاء الذين ورطوا «النحاس» (باشا) فى حادثة 4 فبراير 1942)، وأتذكر أننى وقتها استأذنته أن أذهب قبل تطبيق القرار بتحديد إقامة «النحاس» (باشا) وأشرح له دواعيه، وأن «عبد الناصر» وافق، وذهبت إلى مقابلة «النحاس» (باشا) بالفعل.. وكنت وما زلت حتى الآن على خلاف مع الأسلوب، رغم تفهمى لدوافعه». وقاطعنى «مبارك»: تريد أن تقول إن الرئيس «عبد الناصر» كان يحب «النحاس»؟!! واستطرد: «لا مؤاخذة الرئيس «أنور» قال لى إن «عبد الناصر» لم يكن يحب أحدا». وابتسمت وقلت: هذا رأى الرئيس «السادات» – بأثر رجعى كما يبدو لى، لأنه هو من وصفه فى كتاب بأكمله ب «القلب الكبير الذى يتسع لحب كل الناس وللإنسانية كافة». وقاطعنى: «محمد» بيه أنا أحببت الرئيس «جمال» لا تنسى أننى أسميت أحد أبنائى على اسمه». وقلت: وكذلك فعل الرئيس «السادات». وسألنى: هل أسميت أحدا من أبنائك باسم الرئيس «جمال»؟!! وأجبت بالنفى، بل اخترت لأبنائى أسماء عربية تقليدية وسهلة: «على» و«أحمد» و«حسن». وسألنى الرئيس «مبارك»: «حيرتنى علاقة الرئيسين «أنور» و«جمال» لماذا اختلفا معا أنت كنت شاهدا على العلاقات بينهما، وكنت قريبا من الاثنين، حتى وقعت الواقعة بينك وبين الرئيس «أنور». ◄ ويستطرد هيكل الى العلاقة بينه وبين الرئيسين جمال عبد الناصر والسادات، ومدى معرفته بهما باعتباره أنه كان شاهداً عن قرب، فيوضح هيكل . قائلاً: «فى علاقتى بالاثنين لم أعرف عن خلاف بينهما، ولم يكن هناك لا موضوع للخلاف ولا مجال لوقوعه، ف«أنور السادات» كان دائما وراء «جمال عبد الناصر»، مناصرا، متحمسا، وبعد رحيله 1970، وحتى بعد حرب أكتوبر 1973، وحين اختلفت معه وابتعدت فإن علاقته ب«عبد الناصر» كانت كما عهدتها، ثم بدأت بعد سنة 1974 أسمع من بعيد بالتلميح أولا وبالتصريح ثانيا عن خلاف كان، وعن مواقف وقع فيها هذا الخلاف «المزعوم» واستفحل، وفى البداية بدا لى ذلك غير مفهوم، أو حتى غير منطقى!!». وتداعى هنا حديث حول العلاقات بين الرئيسين السابقين. وانتقل الرئيس «مبارك» من هنا إلى خلافى شخصيا مع الرئيس «أنور»، وقال: كثيرا ما أستغربت، فأنا أعرف أنك وقفت معه «جامد» فى أول ولايته، ثم وقفت معه «أجمد» فى معركة مراكز القوى مايو وكنا جميعا نعرف أنك موضع ثقته، وقد رأيت ذلك بنفسى فى القيادة أثناء الحرب وأضاف: «أنه عرف أننى كاتب التوجه الإستراتيچى الذى صدر للمشير «أحمد إسماعيل» بتحديد أهداف حرب أكتوبر، وهذا فى رأيه «قمة الثقة»، ولهذا فاجأه خلافى مع الرئيس حول فك الارتباط، لكنه لم يقرأ ما كتبت عنه هو يعرف أن الخلاف وقع، لكنه لا يعرف لماذا؟! ◄ ويكشف هيكل عن أن مبارك لم يقرا مقالات الكاتب الكبير، بل وصل به الأمر إلى أنه كان يمنع ضباط الطيران من قراءتها، فيكتب هيكل.. ثم استدرك ضاحكا: «لا تزعل يا «محمد» بيه، إذا قلت لك إننى لم أكن أقرأ مقالاتك رغم «أننى أسمع أن كثيرين يقرأونها»، ولا أخفى عليك أننى كنت أمنع ضباط (الطيران) من قراءتها». وقلت بعفوية: «ياه... لعل السبب خير». قال: «ما كان يحدث أن مقالك «بصراحة» يُنشر فى «الأهرام» يوم الجمعة، ثم يجىء الضباط يوم السبت وقد قرأوه، وكلهم متحفزون لمناقشته، وكثيرا ما كانوا «يتخانقون»، وأنا لا أريد فى السلاح «خناقات» ولا سياسة!!». أضاف: «أما عنى أنا، فقد كنت لا أقرأ مقالاتك لأنى عندما حاولت لم أفهم ماذا تريد أن تقول فى نهاية المقال». بصراحة (على رأيك أضافها وهو مازال يبتسم «مقالك دائما ينتهى دون أن «نرسى على بر» ولا نعرف بعده نتيجة conclusion، قالها بالإنجليزية). وقلت: «سيادة الرئيس هناك مدرسة فى الكتابة لا ترى أن الـconclusion واجب الكاتب، وإنما واجبه: معلومات صحيحة، واجتهادات فى التحليل واسعة، واختيارات فى المسالك المتاحة للحل مفتوحة، ثم يكون للقارئ أن يختار ما يقنعه، بمعنى أننى لا أريد أن يكون ما أكتبه «مقفولا» على نتائج conclusion «تعلِّبه»، وإنما أفضل أن أترك للقارئ حريته بمعنى أن تبدأ علاقته بالمقال بعد أن ينتهى من قراءته، وليس حين يهم بقراءته، لأن هدفى تحريضه على التفكير وهو يقرأ، ورجائى أن يصل بتفكيره إلى حيث يقتنع. وقال: «يا عم» ما الفائدة إذن أن يقرأ الناس «لكاتب كبير»؟! لابد أن «يرسيهم على بر». وقلت: أنا أريد للقارئ أن يرسو على «بره هو»، وليس على «برى أنا»، وعلق بابتسامة مرة أخرى قائلا: «يعنى عاوز تدوخ الناس يا أخى، قل لهم وريحهم».. واختصرت قائلا: «على أية حال فهناك مدارس متعددة فى الكتابة!!». ◄ ويشير الكاتب الكبير إلى أن مبارك عاد مرة أخرى ليسأله عن علاقته بالرئيس السادات، وأعراضه على بعض سياسات الرئيس الراحل، موضحًا أنه عرض ذلك فى أكثر من عشر مقالات ضايقت السادات، فيقول هيكل. وعاد «مبارك» إلى سؤاله عن العلاقات بين الرئيس «السادات» وبينى فقال: «الغريب جدا أننى أحسست أن علاقته بك كانت love - hate complex، قالها أيضا بالإنجليزية (عقدة محبة وكراهية فى نفس الوقت). هو بالحق كان يتحدث كثيرا عنك بالتقدير، لكنه يأخذ عليك أنك تريد أن تفرض عليه رأيك». قلت مستغربا: «سيادة الرئيس كيف يمكن لصحفى أن يفرض رأيه على رئيس الدولة؟!!». رئيس الدولة عنده السلطة كلها وأدواتها تحت يده فكيف أستطيع أنا أو غيرى من الكُتَّاب والصحفيين أن نفرض شيئا عليه؟! ربما يفرض عليه قائد جيش لديه سلاح، أو رئيس حزب لديه تنظيم، أو وزير داخلية عنده بوليس، أما الصحفى فلا يملك غير عرض وجهة نظره ولا أكثر، وهو يضعها أمام الرأى العام إما أن يأخذ بها أحد أو يعرض عنها، فتلك مسألة أخرى خارج قدرة أى صحفى!! ثم قلت: العكس هو الصحيح فيما أظن، فرئيس الدولة هو فى العادة من يريد فرض رأيه على الصحفى، وهنا المشكلة!! أضفت بوضوح يجعل موقفى واضحا أمامه: «وفيما يتعلق بموقفى مع الرئيس «السادات»، فإننى لم أقتنع بما اتخذ من سياسات أثناء أكتوبر وبعدها عندما جاء «هنرى كيسنجر» وأقنع «السادات» وتصرف الرئيس على أساس أن الولايات المتحدة تملك 99% من أوراق حل أزمة الشرق الأوسط، وأن «هنرى كيسنجر» هو من يمسك بالقرار السياسى الأمريكى وكان لى رأى مختلف، وقد تمسكت به وفى ذهنى أن الرئيس الأمريكى بنفسه أو بوزير خارجيته غير قادر على الفعل لأسباب كثيرة، حتى لو أراد، وفى الأوضاع الحالية فإن الإدارة الأمريكية فى شلل بسبب ورطة الرئيس فى فضيحة «ووترچيت». واستطردت: «ومن جانبى فلم أستطع غير التحفظ على هذه السياسة الجديدة، وقد عبَّرت عن أفكارى فى أكثر من عشر مقالات ضايقت الرئيس «السادات»، واعتبر أننى بكتابتها أعرقل توجهاته، ومن هنا كان ضيقه. وفى هذا الموضع من الحديث قلت للرئيس إن ذلك الخلاف قصة طويلة، ولا أريد أن أضيع وقته فيها، لكنه طلب أن يسمع، واستدعى أحد سكرتيريه وأمره بتأجيل موعد كان لديه فى الساعة العاشرة والنصف.
__________________
 |
|
#10
|
|||
|
|||
|
مقالات حقا رائعة أستاذ أبو لميس  |
|
#11
|
|||
|
|||
|
هيكل «الابن» يردم بحيرة مريوط
تقرير «سري جداً» يحذر من غرق الإسكندرية  كتب – السيد سعيد منذ 8 ساعة 7 دقيقة جلوس الفاسدون على سدة الحكم …افرز شرذمة من التجار الذين يملكون رؤوس اموال متوحشة لا تعرف الصالح العام أو تلتفت الى أهمية الأمن القومي للوطن …الذي تحول في عهد الرئيس المخلع حسنى مبارك إلى فريسة ينهش الكل من جسدها ما يستطيع! «الوفد» ترصد بالمستندات والتقارير السرية وصور القمر الصناعي …كارثة تهدد بغرق مدينة الاسكندرية وسكانها في مياه الصرف الصحي «المجارى» ومياه الأمطار وكذلك جريمة جديدة لردم بحيرة مريوط بطلها رجل الاعمال «أحمد حسنين هيكل « نجل الكاتب الصحفى الكبير حسنين هيكل «صاحب شركة القلعة للاستثمارات المالية عندما حصل بتعليمات مباشرة من رئاسة الجمهورية وبموافقة اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الاسبق فى مايو 2008 على قطعة أرض مساحتها 120 الف متر مربع مطلة على ترعة النوبارية بجوار الطريق الدولي وذلك باسم الشركة الوطنية للنقل النهرى تلك الشركة التي «خرجت من رحم شركة القلعة» وذلك بهدف إنشاء ميناء نهرى يربط ميناء الاسكندرية بالمسار الملاحي النهري بالمدينة … وقامت الشركة باختراق كافة القوانين أثناء عملها بالمشروع، حيث قامت بارتكاب جريمة بردم مئات الأمتار من بحيرة مريوط وكذلك ردم مسار الصرف الصحى الخاص بمحطة التنقية الغربية التابعة لشركة إسكندرية للصرف الصحي الذي يصرف من خلاله حوالى مليون مترمكعب من مياة الصرف الصحى فى البحيرة. مما أدى لاختناق مسار الصرف وارتفاع منسوب المياه بالمحطة والذي يهدد بكارثة غرق غرب الإسكندرية بالكامل مع قدوم أمطار غزيرة في فصل الشتاء الحالي والنوات المصاحبة لها!! وذلك تحت سمع وبصر المسئولين في الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية و على رأسهم الدكتور أسامة الفولى!! اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تقرير «سري جداً» يحذر من غرق الإسكندرية الأب يخرب العقول وينتقد الفساد ! والإبن يخرب المدن ويعتبره استثمار! وكلها مصالح وكل منهما يفعل مايراه يخدم الأخر نزعنا مبارك من فوق صدورنا فلماذا نعطى شارة المرور بالسماح لمتابعة المنتفعين القرضاوى - هيكل كل منهما له توجهات تخدم إيران وأمريكا وعبء على صدر مصر أكثر بكثييييييييرمما كانت فيه من قبل متى نتعظ ونستفيق من وهمنا ؟! هذا نفس الرد الذى علقت به فى أكثر من موقع على هذه التفاهات من رجل يعيش خارج مصر منذ قرون وماهذه إلا مقدمة ليعود إليها وهو محمولا على الأعناق وكأنه لم يشارك فى فساد الماضى وأيضا الحاضر !!! شكرا جزيلا
__________________
الحمد لله آخر تعديل بواسطة أ/رضا عطيه ، 22-01-2012 الساعة 07:00 AM |
|
#12
|
|||
|
|||
|
مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان (الحلقة الخامسة) .. للحديث بقية! !  كان الرئيس «مبارك» كما بدا لى وقد طالت جلستنا حتى تلك اللحظة أكثر من ساعتين ــ متشوقا على نحو ما ليسمع، وعندما طلب تأجيل موعد معه فى الساعة العاشرة والنصف، فقد أدركت أننا أمام لقاء سوف يطول، وحتى عندما عرضت الاستئذان كى لا أعطل ارتباطات سابقة له، على أن نعود بعد ذلك ونتقابل فى مناقشة أخرى ــ كان إصراره «أننا الآن هنا ــ إلا إذا كنت «زهقت»، وأكدت أننى لم «أزهق»، ولكن خشيتى على وقته، ولعله أراد طمأنتى ــ وربما إغرائى، فإذا هو يسألنى: ــ ألا تريد أن تدخن سيجارا ــ أنا أعرف أنك من مدخنى السيجار، وأنا مثلك. وأبديت الدهشة، فقال إنه لا يظهر فى الصور بالسيجار لكى يتجنب «القرشنة» ــ!ــ لكنه يدخن سيجارا واحدا كل يوم، ثم ضغط على جرس يطلب صندوق السيجار. وجاء الصندوق مع أحد الضباط، وطلب «مبارك» تقديمه إلى بالإشارة، وأخذت منه سيجارا، وأخذ هو سيجارا. ثم سألنى وهو يرانى أشعل عود كبريت: «سيجار كويس»؟!! ولم أقل شيئا، ويظهر أنه أحس أننى لا أشاركه الرأى. وقلت: «بكل احترام ــ الحقيقة أنه مقبول». وقال باستنكار: «إيه؟! ــ هذا «روميو وچولييت». وقلت: «الشركة التى تنتج سيجار «روميو وچولييت» تنتج أكثر من 75 نوعا بعلامتها، وكل نوع منها مختلف عن الآخر». وسأل «مبارك» باهتمام: «أُمال إيه بقى السيجار الكويس؟!». وقلت «بإذنك فى سيارتى علبة صغيرة فيها سيجار، ولم أدخل بها لأنى لم أتصور أنك تدخن، وإذا وافقت نطلبه». وجاءت العلبة، وعرضت على الرئيس «مبارك» أن يتفضل، فأخذ واحدا منها وأشعله، وكانت ملاحظته: والله أحسن فعلا ــ «غريبة جدا»!! وقال وهو يستعيد الذكريات: «عندما كنا نتدرب فى الاتحاد السوڤييتى كطيارين، كنا نشترى هذا السيجار (الذى لم يعجبك!!) ونبعث به إلى قادة السلاح، وكانوا يعتبرون ذلك «فخفخة»!». ثم عاودته الذكريات فقال: ــ أيام التدريب فى الاتحاد السوڤييتى كنا فى قاعدة جوية قرب «خاركوف»، وفى الإجازة ننزل إلى «موسكو»، وكنا نخفى الورقة «أم مائة دولار» تحت الشراب بعد أن نغطيها بقطعة من ورق التواليت، (أضاف أن ورق التواليت فى روسيا سميك وخشن مثل الخيش)، ثم نغيرها فى السوق السوداء عن طريق موظف فى مكتب الملحق العسكرى بمبلغ كبير من الروبلات، ونشترى علبا من هذا السيجار ونشحنها إلى قادة السلاح فى مصر. واستطرد: كان «الروبل» بالسعر الرسمى يساوى أكثر من دولار واحد، لكن السعر فى السوق السوداء كان 21 روبلا لكل دولار، فارق كبير، أضاف، «لكن الواد بتاع المكتب العسكرى كان جن». 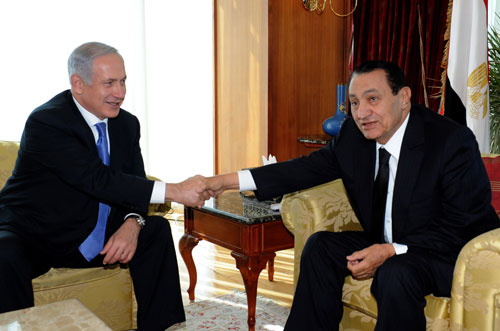 مبارك ونتينياهو ●●● وعاد «مبارك» فجذب نفسا من السيجار الذى قدمته له، وقال: «فعلا لك حق هذا أحسن جدا»، ولكنهم (يقصد القادة الذين كان يرسل لهم السيجار) كانوا يعتقدون أن الاتحاد السوڤييتى يأخذ سيجار كوبا مقابل السلاح، وقلت: «ذلك صحيح إلى حد ما، لكن أفضل أنواع السيجار الذى تنتجه كوبا كانت للتصدير بالعملة الصعبة إلى الغرب، وما تبقى من الدرجة الثالثة والرابعة يذهب إلى الاتحاد السوڤييتى ويشتريه الزوار بحُسن نية». ومد الرئيس «مبارك» يده إلى جرس، فدعى أحد الضباط، ثم التفت وقال: ــ «محمد» بيه ملِّى عليه كل أنواع السيجار «الكويس»! وقلت ما مؤداه «أن لكل نوع من السيجار مذاقا، وأن كل مذاق مسألة اختيار، ولذلك فإنه من الصعب على مدخن أن يوصى غيره بنوع معين». وقال: معلش «ملِّيه» الأنواع «الأبهة» (المتميزة). وكان الضابط قد أسرع وجاء بورقة وقلم مستعدا لكى أمليه. وعاد إلى تجربة «السيجار» الذى قدمته له، وقال: ــ «فعلا كويس جدا». ثم أضاف ضاحكا: ــ يا أخى عاوزين نتعلم «العز». ولفت تعبير «العز» نظرى، وقلت: إنها ليست مسألة «عز»، ولكنها ظروف، وأنا شخصيا تعلمت تدخين السيجار (لسوء الحظ!) من رجلين: «نجيب الهلالى» (باشا)، ثم «فؤاد سراج الدين» (باشا)، كلاهما فى شبابى كانوا يقدمون لضيوفهم سيجارا عندما يشعلون لأنفسهم واحدا، وكنت أقبل الدعوة من باب «التجربة»، لكنى فيما بعد وقعت فى فخ «العادة»! وقال «مبارك»: ــ «إنه لاحظ أن كل الرؤساء الأمريكان يدخنون سيجارا، ويمارسون لعبة الجولف، وأنت أيضا تلعب الجولف». وقلت بسرعة: «صحيح، ولكن بدون رئاسة». وبادر معلقا «والله أحسن يا أخى، الناس تتصور أن الرئاسة شىء عظيم، والحقيقة أنها «بلوة»!!». وقلت شيئا عن لعبة الجولف، وكيف أنها خير معلم للسياسة، وسألنى: كيف؟! ــ وشرحت قدر ما أستطيع لعبة الجولف، وعلاقتها الوثيقة بالعلوم الاستراتيچية. واستمع إلىَّ باهتمام، ثم كان تعليقه: لكنها لعبة تأخذ وقتا، وأنا أفضل السرعة، ولذلك ألعب الإسكواش، وهى لعبة «موصوفة» للطيارين لشحن قدرتهم على الـ Agility «الاستجابة السريعة». ●●● وهز «مبارك» رأسه بأسف وقال: ــ «الآن لا وقت عندى حتى للإسكواش، لأن العبء ثقيل، وطلبات الناس لا تعرف الحدود». وتوقف «مبارك» وتساءل: ــ الناس «كده ليه»؟ ــ ليس عندهم إلا طلبات، يحفظون الحقوق وينسون الواجبات، والمصيبة أنهم جميعا «متخانقين»، وطلباتهم متعارضة، لا أعرف كيف تحمَّل الرئيس «جمال» أو الرئيس «أنور»؟! ــ أنا شخصيا، ولم أقض فى الرئاسة إلا شهورا ــ «طلعت روحى»!! أشار إلى تخبط القوى السياسية، وصخب الصحافة والصحفيين. وقال «مبارك» ويداه تسبقان إلى التعبير عما يريد قوله: ــ «والله لو تعبت من كثرة الطلبات والخلافات، سوف أتركها لهم، وأسلم كل شىء للقوات المسلحة، وأترك الجميع «ياكلوا فى بعضهم»، وأخلِّص نفسي!!». (وكأنها كانت نبوءة مبكرة!!). ورجوته ألا يفكر على هذا النحو. ●●● وعاد «مبارك» مرة أخرى إلى خلافى مع الرئيس «السادات»، وكان فى واقع الأمر يفصح عن آرائه هو نفسه ــ يقول: ــ «السادات» كان على حق، لا أعرف لماذا اختار الرئيس «جمال» صداقة السوڤييت، وهم ناس «فَقْرى»، و«السادات» اختار الأمريكان وهم «المتريشين» (يقصد الأغنياء)، أكبر خطأ وقع فيه الرئيس «عبد الناصر» هو الخلاف مع أمريكا. استطرد: «وبعدين الرئيس «أنور» اختار السلام مع إسرائيل، والرئيس «جمال» كان لابد أن يعرف أنه لا فائدة من الحرب مع إسرائيل». واستطرد: «اليهود مسيطرين على الدنيا كلها، وأنت تعرف أكثر!! اسمعها منى لا يستطيع أحد أن يختلف مع أمريكا». أنا أعرف أنك كنت من أنصار علاقات طيبة مع أمريكا ــ فلماذا غيَّرت رأيك؟!!». وأجاب بنفسه على سؤاله: ــ «يا عم»، الذى لا يعرف أن أمريكا هى أقوى قوة فى العالم ــ «يعك». ولم أعلق على الكلمة، ففى أثناء الحديث سمعت من هذا النوع من الكلمات «عينات» متكررة. ورحت أشرح له رأيى: ــ «أننى لا أختلف على أن أمريكا هى أقوى قوة فى العالم، ولكن المسألة هى: من أى موقع يتعامل الأطراف مع القوة الأمريكية» (استطردت وبشكل ما فقد قصدت أن يصل إليه ما كنت أقول)، إذا تعاملت مع أمريكا من منطق أنك تحتاج إليها، فلن تصل إلى شىء، وإذا تعاملت معها باعتبار أنها فى حاجة إليك، فقد تنجح». وقاطعنى: ــ «تريد أن تقول لى إن أمريكا تحتاج إلينا ــ طبعا لا ــ نحن الذين نحتاج إليها!!». وقلت: ــ «سيادة الرئيس.. إن الاحتياج لابد أن يكون متوازيا فى السياسة الدولية، وإذا جاء الاحتياج من طرف واحد ــ إذن فهو عالة على غيره، وحتى إذا قبل هو، فإن الطرف الآخر لن يقبل، ببساطة لأن السياسة الدولية ليست جمعية خيرية!!». وأضفت: ــ «أنه هنا أهمية موارد مصر الاستراتيچية، وقدرتها على إدارة هذه الموارد، وهنا مثلا أهمية انتماء مصر العربى. بمعنى إذا لم تكن مصر من هذه الأمة العربية بالطبيعة، فلابد أن تكون منها بالضرورة. بصراحة، أنا قومى عربى باقتناع، وبطبائع الأشياء فإن أحدا لا يستطيع الاقتناع إلا بما يتوافق مع مصلحة وطنه كما يقدرها ــ وفضلا عن اقتناعى ــ مبدأ ــ بعروبة مصر، فإننى مقتنع بضرورة هذه العروبة أيضا لمصر، وكذلك لكل بلد عربى». ثم قلت: «فارق ــ سيادة الرئيس ــ بين أن تتعامل مع أمريكا كمصر فقط ــ وهى بلد مثقل بحجم سكانه، محدود فى طاقة موارده، وبين أن تتعامل معها وهى وسط العالم العربى ــ بكل قوة الأمة، وبجميع إمكانياتها ومواردها!!  السادات وكارتر ●●● زدت على ذلك: ــ هذا أيضا ــ سيادة الرئيس ــ هو ما يمكن أن يعطيك تأثيرا فى العالم الثالث كله وفى العالم الأوسع، إذا كنت وحدك، فالتأثير محدود، وإذا كنت وسط كتلة كبرى، إذن فهناك حساب آخر لتأثيرك». أضفت: «مذكرا الرئيس بحوار منشور لى مع «كيسنجر» يوم 7 نوفمبر 1973، فى أعقاب حرب أكتوبر، وكان هو الآخر قد اقترح عليَّ فى حينها أن أقتصر فى كلامى معه على ما يخص مصر وحدها، دون العالم العربى، وكان ردى عليه: أنه يريد أن ينزع أهم أوراقى التفاوضية من أول لحظة». وذكرت له كيف قلت لـ«كيسنجر» وذلك منشور فى مقال لى فى «الأهرام» ذلك الوقت: ــ دكتور «كيسنجر»: أنت أستاذ علوم سياسية، ولا يصح لى أن ألف وأدور معك أو ألعب «الاستغماية» Hide& seek، ولذلك أحدثك بصراحة: إذا اقتصر اهتمام مصر على قضاياها وحدها، فهى تحتاج لكم. إذا كانت مصر وسط أمتها العربية فأنتم تحتاجون لها. ولذلك دعنا من أول لحظة نتفق على أن اهتمامات مصر حتى بصرف النظر عن هويتها ــ عربية، وهى تريد علاقات طيبة معكم، لكن عليكم أن تقدروا بأنفسكم أنكم أيضا فى حاجة إلى علاقات طيبة معها. (والحقيقة أننى قصدت أن أتوسع أمام «مبارك» فيما قلت لـ «كيسنجر»، حتى تصل وجهة نظرى إليه، دون أن تتبدى «وعظية» إذا وجهتها مباشرة إليه).  جمال عبد الناصر وبرجينيف وقطع «مبارك» سياق كلامى قائلا: ــ «هذا هو ما جلب لنا المشاكل، والحقيقة أننى مختلف معك ــ وموافق مع الرئيس «السادات» ــ فمشكلتنا أننا تحملنا بمشاكل غيرنا وليس مشاكل مصر وحدها، نقتصر عليها ونحلها بأسلوب عملى». وقلت: لا أظن أن هناك ــ فى عزلة عن العالم العربى ــ حلا لمشاكل مصر وحدها ــ لا خيالى ولا عملى!! ●●● عاد الرئيس «مبارك» إلى حديث «أمريكا» ــ قائلا: ــ «أنت تنسى أنه لا أحد يستطيع مساعدتنا على إسرائيل إلا أمريكا، العرب شمتوا فينا سنة 1967، مع أنهم هم الذين ورَّطونا فى الحرب». وأضاف: ــ «أنا أعرف «الأسد» (يقصد «حافظ الأسد») من أيام الطيران، وهو قال لى إن «حزب البعث» قصد توريط «عبد الناصر» فى حرب سنة 1967». واستطرد فى تفاصيل علاقته مع «حافظ الأسد». وقلت: «إننى معه فى أن نظما بعينها هنا وهناك حاولت مرات توريط «عبد الناصر»، ثم رُحت أشرح له بعض ظروف القرار السياسى سنة 1967، وضمنه ــ وبصرف النظر عن التربص الخارجى ــ أن القرار المصرى وقع فى أخطاء لم يكن هناك مبرر لها، أخطرها قرار الانسحاب من سيناء بكل القوات فى ليلة واحدة (7 يونيو 1967)». وأخذنا هذا الحديث إلى كلام إلى تفاصيل متشعبة عن ظروف وملابسات سنة 1967، وحكى لى أنه كان مع سرب القاذفات المتمركزة فى مطار «بنى سويف»، وقال إنه قرأ التحقيقات التى جرت عن تلك الحرب، لأن الرئيس «السادات» عينه رئيسا للجنة كتابة التاريخ عندما كان نائبا له، وأنهم استطاعوا فى اللجنة أن يجمعوا أكثر من مليونى ورقة من الوثائق، وأنه اطلع على بعضها بنفسه، لكن ضيق الوقت لم يمكنه من قراءة الكثير». أضاف «أنه مع ذلك يعتقد أن علاقاتنا مع أمريكا من ألزم الضرورات، وبالتحديد فيما يتعلق بإسرائيل». ثم استطرد وهو يهز رأسه: ــ «بعض الناس يريدوننى أن أقيم علاقات كاملة مع إسرائيل ــ ويريدون ذلك الآن ــ ولكن عليَّ الانتظار ــ أنا أنتظر على أحر من الجمر أن يجىء أبريل ويخرجوا من الأرض المصرية كلها». أضاف: «هل يظن الناس أن التعامل مع الإسرائيليين يسعدنى؟! ــ هناك فارق بين أن أعترف بقوة إسرائيل، وبين أن أحبها!!». ثم استدرك: «محمد» (بيه) أقسم لك أنهم «يسمُّون بدني» فى كل مرة ألتقى «بواحد منهم»، أتضايق منهم ويفوت منى موعد نومى وأسهر الليل أشتمهم». وقلت: «إننى أفهمه، لكنه من حسن حظى أننى لست مضطرا لمقابلتهم، ولهذا فأنا كمبدأ لم أقابل منهم أحدا». وقال بسرعة: «ولكن كيف تستطيع أن تفعل ذلك إذا كنت مسئولا؟!». وقلت: «ولكنى والحمد لله غير مسئول».  عبد الناصر يترأس إحدى القمم العربية ●●● وقال الرئيس «مبارك»: ــ هذا موضوع كنت أريد أن أكلمك فيه». ثم استطرد قائلا برقة بادئا بكلام كريم، لكن نبرة العتاب تشيع فيه: «الرئيس أنور» تعب معك حتى تتعاون معه». وسألته: «كيف يستطيع أحد أن يتعاون فى سياسة لا يؤمن بها؟!». قال: «تستطيع أن تساعد دون أن تتعامل مع إسرائيل». وقلت: «إن منصب الوزارة عرض من سنة 1956، وكنت لا أزال شابا قد تغريه المناصب، والرئيس «السادات» عاد بعد ذلك فعرض عليَّ منصب نائب رئيس الوزراء، أو رئيس الديوان السياسى». وقال: «أعرف ذلك، ولم أقصد أن أحدثك عن منصب». أسألك سؤالا صريحا ومحددا ــ قالها وهو يتطلع إلىَّ مركزا: «ما رأيك أن تدخل الحزب الوطنى؟!!». وبدا أننى أصبت برعب، وقلت له: إننى لم أدخل الاتحاد الاشتراكى مع «جمال عبد الناصر» رغم عمق صداقتنا ورغم إلحاحه مرات ــ لأنى لا أعتقد فى هذا النوع من التنظيمات السياسية التى تقوم فى حضن السلطة، وفضلا عن ذلك فلست من أنصار أن ينتمى الصحفى حزبيا». ●●● سكت قليلا ثم سألنى: «إذا لم تكن تفكر فى دخول الحزب، فماذا تنوى أن تفعل؟!». أضاف: «لا يُعقل أنك سوف تجلس فى بيتك ساكتا!». وقلت ضاحكا: «أنه ليس له أن يقلق، فأنا لا أنوى الانضمام إلى قائمة المتعطلين الذين يبحثون عن عمل». أضفت: «لديَّ عقود لكتب جديدة مع «الناشرين» فى لندن ونيويورك بعد ستة كتب سبقت، تُرجمت وجميعا من الإنجليزية إلى لغات كثيرة، وآخرها كان كتاب «عودة آية الله» The Return of The Ayatollah عن الثورة الإيرانية، وقد صدر فى أوروبا وأمريكا أثناء وجودى فى السجن، وقد تُرجم حتى الآن إلى سبع عشرة لغة ــ ثم إنه فور خروجى من السجن اتصل بى «أندريه دويتش» وهو أكبر الناشرين فى لندن، وسألنى إذا كان فى استطاعتى أن أقدم لهم بسرعة كتابا عن السبب الذى دعا إلى اغتيال «السادات»، وهو فى رأيهم «بطل السلام»، وقد قبلت عرضه، وذلك ضمن ما سوف أناقشه فى سفرة قريبة إلى لندن». وقاطعنى: «كتاب عن الرئيس «أنور»؟!! وقلت: «ليس عنه، ولكن عن عملية الاغتيال بالتحديد، وقد عثرت على عنوانه وأنا فى السجن، فقد كنت أفكر فى شىء من هذا القبيل، حتى قبل أن يتصل بى أحد من لندن، وعثرت أثناء تفكيرى فيه على عنوان له: «خريف الغضب»!. وكرر الرئيس عنوان الكتاب المقترح كما سمعه منى، وبدا حائرا فى فهم مقصدى به، لكنه تجاوز حيرته. وعلَّق بقوله: «ولكن هذا سوف يسبب لك مشاكل كثيرة، لأن الرئيس «أنور» له «جماعات كبيرة»!». وقلت: «أما عن المشاكل فقد تعوَّدت عليها، ثم إننى أرجوك أن تعرف أن الرئيس «السادات» كان صديقا، وليس مشكلة أن تختلف آراؤنا، وأن تتباعد الطرق بيننا، لكن ذلك لم يترك أثرا لدىَّ». زدت على ذلك: «أنه عندما وقع اغتيال الرئيس «السادات» وعرفت به فى السجن، فإنى بكيت عليه بصدق، وساعتها زال كل أثر للخلاف وما ترتب عليه، لأن الدم والدموع غسلت كل شىء!!». ●●● وجاءنى تعليقه مفاجئا: «لم أكن أعرف أن الكتب «شغلانة كويسة»!! وقلت: «أننى لا أعرف تصوره لـ «الشغلانة الكويسة»، لكن الكتابة بالنسبة لى حياتى كلها!!». وعاد يسألنى: «ولكن ألا تفكر فى العودة للصحافة المصرية؟!». وقلت: «إن ذلك بعيد عن تفكيرى تماما، فقد اعتبرت أن دورى فى الصحافة المصرية انتهى بخروجى من «الأهرام»، وأوثر أن أترك المجال لآخرين، وكذلك لأجيال أخرى». ووجدها فرصة يعود بها إلى اقتراحه، فقال: «خسارة ألا يستفيد منك البلد» ــ وسألته: «ألا يرى فى وجود صحفى وكاتب مصرى فى مجال النشر الدولى فائدة للبلد؟!!». وشرحت بعض التفاصيل عن حجم النشر الدولى، سواء فى الكتب أو فى الصحف، وبالتحديد عندما يقع الجمع بين الاثنين، فيصدر كتاب، ثم تُنشر فصول منه فى آلاف الصحف على اتساع العالم. ●●● ورد بأنه مازال يرى «أن أنضم إلى الحزب الوطنى، والمجال فيه بلا حدود»!! وقلت: «أنت تريد أن تضمنى إلى الحزب الوطنى، وأنا وغيرى نريدك أن تخرج منه». وسألنى عن السبب، وهل الأحزاب «بعبع»، أو أنها وسيلة العمل السياسي؟! ــ وقلت: «الصحفى بصفة عامة يتعامل مع الأخبار، والأخبار لها استقلالها، وتلوينها بظلال التحزب، مخالف لقيمتها ومصداقيتها». واصلت الحديث: ــ ولعله يتذكر يوم جئناه من المعتقل قبل أيام ــ أنه سمع بعضنا يناشدونه مباشرة لترك رئاسة الحزب الوطنى، وقلت إنه فى العادة وفى النظام الرئاسى بالذات، فإن الرئيس حتى وإن كان منتميا إلى حزب، يجمد انتماءه لهذا الحزب فترة رئاسته. وقال بلهجة قاطعة: «لو تركت الحزب فسوف يقع». وقلت: إذن فإن الحزب لا وزن له فى حد ذاته، وهو يستمد وجوده من السلطة، وليس من الناس، وهذا هو الخطر. قال: ــ «تخوفك من الحزب الوطنى مُبالغ فيه، ووجودى فيه ليس المشكلة، المشكلة فى العمل التنفيذى، فى الحكومة وأنت تعرف حجم المشاكل، وزاد علينا خطر الإرهاب، والناس تطلب «لبن العصفور»، ولابد من الاستقرار قبل أن نستطيع عمل أى شيء، والجماعات الإرهابية كامنة، وتنتشر تحت الأرض». ●●● وبدورى قاطعته: ــ «والنظام يساعدها». واستغرب ما قلته وهو يسألنى: ــ «النظام يساعدها ــ كيف؟!». قلت له: «هناك بالطبع المشاكل الاقتصادية الاجتماعية، وهذه مشاكل ثقيلة، لكن هناك أشياء أخرى منها مثلا كثرة البرامج الدينية البعيدة عن قيم الدين، وكثرة الفتاوى فيما لا علاقة له بروح الدين.. كل هذا يسيء ــ لكن كله يشحن!!». وزدت فقلت: «إننى سألت أحد زملائنا القُدامى فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيچية فى «الأهرام» أن يدرس مساحة البرامج الدينية على الإذاعة والتليفزيون، وفوجئت حين قيل لى إن نتائج بحثه فى الموضوع، أظهرت أن أكثر من 27% من مساحة البرامج ــ دينية، أو ذات طابع دينى، وأنا رجل من أسرة متدينة، وأعرف قيمة الدين هداية وعصمة، ثم إننى من أسرة كان أول تقاليدها أن يحفظ أبناؤها القرآن، وقد حفظته كله، لكنى لا أستطيع أن أتصور بعض ما يُقال فى البرامج الدينية. أضفت آسفا: إننى سمعت بنفسى من «إذاعة القرآن الكريم» من القاهرة، وفى معرض برنامج من برامج التواصل مع السامعين، سائلا يستفسر عن «كيفية الاغتسال بعد ممارسة ال*** مع بقرة»، وبقدر ما أفزعنى السؤال، فقد أفزعنى أكثر أن أحد الشيوخ جاوب عليه، وراح يحدد لسائله وسائل الاغتسال المطلوبة فى تلك الحالة!!». وأغرق «مبارك» فى الضحك ــ ثم قال: ــ «التوسع فى البرامج الدينية ضرورى، لأننا لابد أن نواجه الإرهابيين على أرضيتهم، ونأخذ منهم الناس». وقلت: ــ «المشكلة أنك إذا واجهت الإرهابيين على أرضيتهم، وبهذه الطريقة، فسوف تقبل الاحتكام إلى قانون لا تعرف مصدره، ولا تعرف نصه، ولا تعرف قاضيه». وتوقف عند هذا التعبير وبدت عليه الحيرة، وقال لي: «هل يمكن أن تفك لى هذا الكلام «الملعبك»؟!! وحاولت شرح وجهة نظرى بأسلوب آخر!! وقال وهو يعاود الضحك: ــ «هل علىَّ أنا أيضا أن أهتم بالرجل الذى يعشق (استعمل لفظا آخر غير العشق!) ــ بقرة؟!!». وقلت له بسرعة: «لا أحد يتصور أن يطلب منك ذلك، ولكن الناس تطلب رؤية للمستقبل مقنعة». ●●● ووصل الحديث بنا إلى أسلوب عمل رئاسة الدولة، واقترحت «أنه من الضرورى والرئاسة بهذا الدور المركزى ــ أن يُعاد تنظيمها بطريقة ملائمة للعصر». وسألنى عما أعنى، وقلت: «إننى لاحظت منذ خرجنا من المعتقل قبل أسبوع، أن الرئاسة تُدار بأسلوب يحتاج إلى مراجعة». وكان يسمعنى باهتمام، وواصلت: «إننى سمعت من أصدقاء بينهم «فؤاد سراج الدين»، و«ممتاز نصار»، أنك بعثت إليهم برسائل منك أو ملاحظات مع «أسامة الباز»، وذلك حدث معى شخصيا أيضا ــ و«أسامة» كما تعرف صديقى، وكان يعمل معى لسنوات، وأنت تثق فيه ولا أفهم لماذا تجعله يعمل بطريقة «بائع متجول على عربة يد»، تبعثه برسالة إليَّ، أو رسالة إلى غيرى، لماذا لا تعين «أسامة الباز» وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية، وتُنشئ له مقرا فى القصر الرئاسى يعرفه الناس، وتكلفه بإنشاء مكتب فيه خبراء فى القانون والاقتصاد، ومتحدث رسمى باسم الرئاسة يعبر عن رؤاها فى الداخل وفى الخارج، وبذلك يكون هناك مصدر معروف تصدر منه الرسائل والتوجُهات، ومقر يذهب إليه الناس للاتصال والتشاور!! وقال بلهجة تنم عن تردد: ــ «المسألة أننى لا أريد أكرر ما يسمح بظهور مركز قوة فى الرئاسة، وأنت تعرف تجربة «سامى شرف» مع الرئيس «جمال»، المشكلة أن وجود رجل فى مثل هذا الوضع قد يؤدى إلى عُزلة الرئاسة عن الناس بوجود رجل يستطيع أن يحجب ويسمح بما يشاء، وهى مشكلة عرفناها». وقلت: «إن الأمر يتوقف على شخصية الرئيس، وأسلوب عمله، ومع ذلك فدعنى أقل لك إن «سامى» مظلوم فى بعض ما قيل عنه، ومع ذلك فإن الأمر يتعلق بك أنت وأسلوب عملك». وأضفت: «وأنا شخصيا أرى أن ترسل أحدا إلى البيت الأبيض فى واشنطن، أو إلى «10 دواننج ستريت» فى لندن، ليدرس كيف تُدار مكاتب رؤساء الدول فى هذا العصر الجديد، وتقرر ــ أنت ــ على هذا الأساس أى نظام يحقق لك ما تريد بأقصى قدر من الكفاءة!!». وحدثته عما أعرفه عن تنظيم البيت الأبيض ــ ومجلس الأمن القومى ــ ونظام العلاقات مع الكونجرس ــ ومع الحزب ــ ومع الإعلام ــ وعن مؤسسات السلطة فى الداخل والخارج. وحدثته كذلك عما أعرفه عن تنظيم «10 دواننج ستريت»، وعن مطبخ القرار السياسى، وعن مكتب الاتصال مع الحزب فى المعارضة أو فى الحكم، وعن منصب سكرتير عام مجلس الوزراء الذى يرأس المجلس التنفيذى للوكلاء الدائمين للوزارات». وقلت: «إننا نحتاج إلى دراسة تجارب الآخرين». وقال: «مازلت أفضل أن أعمل مباشرة بمجلس الوزراء كله.. المجلس هو مكتبى، هو نفسه سكرتارية الرئيس!». وقلت: «إن ذلك مستحيل عمليا، ولابد أن يكون للرئيس مكتب فيه خبراء للشئون السياسية والقانونية والاقتصادية، يدرسها ويقدم له توصيات بشأنها، وإلا فإن الرئيس ليس أمامه فى هذه الحالة إلا أن يوقع مشروعات المراسيم بقوانين كما تصل إليه من مجلس الوزراء، وفى هذه الحالة فإن الرئاسة لا تعود مركز توجيه العمل الوطنى، وإنما تصبح توقيعا وختما على المراسيم، يحولها إلى قوانين!!». وبدت عليه أعراض تحيُّر، وقال: ــ «كلامك فيه منطق، و«أسامة الباز» له معى تجربة طويلة!». قلت: «هو موضع ثقتك وهذا مهم، وأنا أعرف أن «أسامة» لديه «شطحات بوهيمية» فى بعض الأحيان، لكنه من المحتمل أن بعض ذلك عائد إلى أنه يعمل بلا مكتب وبلا مؤسسة معه، وإنما هو رجل وحده، وهذا ما قصدته ــ بصراحة ــ حين قلت لك إن الرئاسة تعمل بمنطق «البائع المتجول». وقال بما بدا لى أنه على استعداد للبت فورا فى المسألة: ــ «لك حق، ولابد أن يفهم «أسامة» أن عليه العمل بطريقة منظمة». ثم رفع سماعة التليفون وطلب توصيله بـ«أسامة الباز»، وبعد خمس دقائق دق التليفون ورفع الرئيس سماعته، ثم التفت إليَّ يقول: ــ «هل رأيت ــ «أسامة» ليس هنا، بحثوا عنه فى كل مكان، ولم يعثروا له على أثر». وقلت دفاعا عن «أسامة»: ــ «لابد أنك كلفته بمهمة فذهب إليها». وقال «مبارك»: «سوف أرسله إليك فى مكتبك، وقل له كل ما تتصوره حتى أناقشه معه وأقرر». ●●● وقارب اللقاء نهايته، وبينما أهُمْ بالقيام ــ استدعى الرئيس «مبارك» أحد أفراد سكرتاريته، وطلب منه أن يكتب على ورقة كل أرقام التليفونات الخاصة بمكتبه، بما فيها تليفونه الشخصى، طالبا أن أتصل به «فى أى وقت». وقلت للرئيس: «إن هذه رخصة أعتز بها لكنى لا أنوى استعمالها، وأفضل ترك أمر الاتصال فى أى وقت له، فهو رجل مشغول على الآخر، وجدول أعماله يجب أن يكون ملكه، دون إلحاح عليه من أحد». وأضفت: «لو أننى استعملت هذا الترخيص الذى تفضَّل بإعطائه لى، لما كففت عن إبداء الملاحظات، وأول الدواعى أننى مختلف مع مجمل السياسات المُعتمدة، وإذا رُحت أبدى رأيا فى كل ما أشعر بالقلق منه، فسوف أجد نفسى أقوم بدور من «لا يعجبه العجب»، وذلك دور لا أحبه!!». ورحنا نمشى نحو الباب، ولمح «مبارك» مصوِّر الرئاسة المشهور، الأستاذ «فاروق إبراهيم» يتحرك من بعيد، والتفت نحوى قائلا: «دعنا نلتقط صورة معا»، وقلت للرئيس صراحة: «أننا نستطيع أن نستغنى عن الصورة، وربما كان ذلك أفضل». ووقف فى مكانه وتطلع إليَّ وهو يعلِّق: «غريبة ــ الناس يجيئون إلى مقابلتى وليس لديهم غرض إلا هذه الصورة». وقلت: أننى كنت أقابل «جمال عبد الناصر» مرتين وثلاث مرات فى الأسبوع، وكذلك «السادات»، وكانت اتصالاتنا التليفونية عدة مرات كل يوم، ومع ذلك لم تُنشر صورة للقاء، ولا خبر عن اتصال تليفونى، وأنا لا أفهم «بدعة» نشر أخبار أو صور لقاءات الصحفيين مع الرئيس، لأن هذه «طبائع أشياء»، و«طبائع الأشياء» ليست خبرا ــ وتدارك قائلا: «والله لك حق، إننى أقابل كل الناس ولا يحدث شيء، لكنه عندما «عرفوا» أننى سأقابلك ــ «ولعت «اللمبة الحمراء» فى الصحافة وفى الحكومة وفى الحزب». ولم أملك نفسى، فقلت: «سيادة الرئيس.. هل هناك بالفعل حزب؟!». وهز رأسه قائلا: «أنت مصمم على رأيك فى الحزب، الحزب مهم فى الاتصال بالناس وفى «تمرير القرارات»، ولفتت الكلمة الأخيرة نظري!!». ●●● ومساء نفس يوم المقابلة اتصل بى «أسامة الباز»، ومر علىَّ فى مكتبى، يحمل فى يده دفترا من الـ Yellow Pad الذى يستعمله القانونيون فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبادرنى قبل أن يجلس أمامى: ــ ما الذى اقترحته على الرئيس؟!! ورويت له أطرافا تخصه مما دار فى حديثى مع «مبارك»، وكان رده: ــ «أنت تضيع وقتك، هو له طريقة فى العمل مختلفة، وهو يفضل أن يسمع من هنا ومن هناك، ويتصرف بما يرى (وهذا كلام لك)، وسوف ترى. وهو لن ينشئ وزارة لشئون رئاسة الجمهورية، ولن يعيننى وزيرا لها». وتشعَّب الحديث بيننا، وأثناء خروجى لاحظ «أسامة الباز» وهو يمر عليَّ حيث أجلس فى مكتبى، أن هناك أوراقا كثيرة مكتوبة بخطى، وبمعرفة سابقة ووثيقة فإنه قال لي: «أراهن أن هذه الأوراق كلها نقط حديثك معه». وقلت: «إن ما خطر له صحيح». |
|
#13
|
|||
|
|||
|
مبارك وزمانه من المنصة إلي الميدان (الحلقة السادسة) .. فى باريس حگايات أخرى! ربما كان اختيار «مبارك» دون غيره من «المرشحين المحتملين» نوابا لرئيس الجمهورية ــ مفاجئا لى (رغم كل ما كنت عرفته من علاقات سابقة بين الرجلين، خصوصا تلك التجربة المشتركة فى «الخرطوم»!)، لكن احتمال اختياره ــ كما أبدت لى الظروف ــ لم يكن على الأرجح مفاجئا لغيرى. وفى الواقع فإن «احتمال اختياره» تبدَّت له أمامى إشارات عابرة، وفى بعض الأحيان غامضة، وكانت فى مجملها تكشف تباعا لمحات يصعب إهمالها ــ وكانت فاتحة الإشارات ما حدث ذات صباح من يناير 1982 فى قصر «الإليزيه» فى باريس، وكنت على موعد مع «فرانسوا ميتران»، وكانت تلك مقابلتنا الأولى بعد أن أصبح رئيسا لفرنسا. كنت قد عرفت «فرانسوا ميتران» مبكرا عندما كان رئيسا للحزب الاشتراكى، ودعوته لزيارة القاهرة، ولبَّى الدعوة، ومن يوم 25 يناير 1974 ولعشرة أيام كان الرجل ضيفا على «الأهرام» وعلىَّ فى مصر، وبالطبع كنت ألقاه كل يوم تقريبا، كما رتبت أن يشارك فى جلسات متعددة مع خبراء من مركز الدراسات السياسية والإستراتيچية ــ ومع عدد من مفكرى «الأهرام» وقتها، وفى هذه الجلسات جرت مناقشة قضايا عديدة سواء فى السياسة الدولية، أو فى التحولات الكبرى التى ظهرت بوادرها على الأفق مع تلك المرحلة الأخيرة من الحرب الباردة. وقد كتب «ميتران» بعد ذلك فى كتاب له عنوانه «حبة فى السنبلة» ــ فصلا كاملا عن لقاءاتنا معا، وعن الحوارات التى شارك فيها مع من دعوت من زملائى، كما أنه اهتم فى هذا الفصل من الكتاب طويلا بالعلاقة التى رآها بين الرئيس «السادات» وبينى، وكنت قد اصطحبت الزعيم الاشتراكى معى إلى مقابلة معه فى بيته فى الجيزة. وبعد تلك الزيارة إلى مصر أوائل سنة 1974، فإن علاقتى مع «فرانسوا ميتران» توطدت أكثر بلقاءات متكررة فى باريس معظمها فى بيته فى حى «سان چيرمان»، حيث كنا نجلس ساعات الصبح فى مكتبه بالدور العلوى من بيته، ثم نخرج مشيا على الأقدام إلى الغداء فى مطعم «ليب» على ناصية قريبة، ونجلس لحديث يسترسل دون مقاطعة ودون تحفظ. *** وفى مايو 1981 ــ انتخب «ميتران» رئيسا لفرنسا، ثم وقع بعدها بأسابيع أننى وجدت نفسى فى سجن «طرة» مع كثيرين. ومن وراء الأسوار فى «طرة» تسرب إلينا أن الرئيس «ميتران» اتخذ موقفا معارضا ومعلنا ضد اعتقالات سبتمبر فى مصر، وبلغنا أنه دعا المكتب السياسى للحزب الاشتراكى لاجتماع خاص، وأدان هذه الاعتقالات، ولم يكن «ميتران» يستطع إعلان إدانته لها كرئيس للدولة الفرنسية، وكان حله أن يعلنها كرئيس للحزب الاشتراكى، ووصل إلينا أيضا أن الرئيس «السادات» غضب وهدد بقطع العلاقات مع فرنسا، لأنها تدخلت فى الشأن المصرى، حتى وإن كان رئيس الدولة الفرنسى قد أبدى رأيه بوصفه رئيسا للحزب الاشتراكى!*** وهكذا ومع أول رحلة قمت بها لأوروبا بعد الإفراج عنا ــ بعثت إلى الرئيس «ميتران» فى يناير 1982 أبلغه بموعد قدومى إلى «باريس»، ومدة بقائى فيها، تاركا له أن يحدد موعدا نلتقى فيه، ثم كان أن اتصل بى مكتبه يبلغنى دعوة على الإفطار مع الرئيس فى الساعة الثامنة والنصف «صباح الاثنين المقبل».وعلى الإفطار ومع حديث استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، سألنى «ميتران» عن علاقتى بالرئيس الجديد «مبارك»، وهل أنها طبيعية أو عاصفة، كما كانت مع الرئيس «السادات» فى سنواته الأخيرة، وقلت: «إننى التقيت الرئيس الجديد أخيرا ولعدة ساعات، وأنه يبدو لى رجلا معقولا، يستطيع أن يتعلم من منصبه ويكبر فيه» ــ ولاحظت أن «ميتران» يسمعنى مهتما، دون أن يبدو منه رد فعل، وكانت ملاحظته الوحيدة بإشارة سريعة قوله: «على أى حال إن بعض الناس عندنا يعرفونه جيدا». وسألته عما يعنيه بهذه الإشارة، وكان رده بنصف ابتسامة، إيماءة إلى تعبير مأثور عن الكاردينال «ريشيليو» السياسى الأكبر فى بداية التاريخ الفرنسى، وهو تعبير Raison d’etat «أسباب دولة»، وتشعب بيننا الحديث، لكنه لفت نظرى أن «ميتران» ذكر أكثر من مرة بعد ذلك اسم الكونت «ألكسندر دى ميرانش» الذى كان مديرا للمخابرات الخارجية الفرنسية SDECE، وبتجربة صحفى فقد راودنى الإحساس بأن هناك فى باريس مَنْ يعرف أكثر عن الرئيس المصرى الجديد، وأن «دى ميرانش» أحدهم. *** وكنت أعرف الكونت «ألكسندر دى ميرانش» من تجربة سابقة رتب لها ــ أيضا ــ رئيس فرنسى (سابق) ــ هو الرئيس «چيسكار ديستان»، الذى قابلته منذ خمس سنوات، وفى صالون نفس المكتب (الذى أقابل فيه «ميتران» الآن). وفى ذلك اللقاء مع «چيسكار ديستان» كنا جالسين فى الصالون الملحق بالمكتب الرئاسى على مقعدين متواجهين وبيننا مائدة للشاى من طراز «لويس الخامس عشر»، وتحت «چيسكار ديستان» رقدت كلبته «أنتيجون»، وقد أراد تبرير وجودها بأنها لا تستطيع أن تبتعد عنه، بل هى دائما وراءه من غرفة نومه إلى قاعة مكتبه، وحين ناولها قطعة صغيرة من فطائر وضعوها فى طبقه، وجد مناسبا ــ فيما أظن ــ أن يشرح لى مبررا إضافيا لحضورها قائلا: «هى لا تتكلم، وإخلاصها بغير حدود وكتمانها مضمون ومأمون» ــ ثم أضاف: إن ذلك الإخلاص المتجرد نادر فى العلاقات بين البشر!!). وطال الحديث وتشعَّب وبدا لى أن الرئيس «ديستان» مشغول بأفريقيا، وحديثه مركز عليها، واعتقاده أن تغلغلا شيوعيا يتسرب حثيثا إليها، ثم إلحاحه: «أن العرب يجب أن يتمثَّلوا خطورة الأوضاع فى أفريقيا، لأن التحدى الذى يواجهه العرب والغرب معهم ــ تحدٍ خطر!!». وأسهب الرئيس «ديستان» فى الشرح: «1ـ قناة السويس مازالت مغلقة، رغم انتهاء حرب «يوم الغفران» (هكذا وصف الرئيس الفرنسى حرب أكتوبر). 2ـ وإمدادات النفط من الخليج تضطر للدوران حول أفريقيا عن طريق «رأس الرجاء الصالح» لكى تصل إلى أوروبا وإلى أمريكا. وأمريكا تستطيع أن تستغنى عن البترول العربى مؤقتا، وأما أوروبا فذلك بالنسبة لها مستحيل. ودوران ناقلات البترول حول أفريقيا على الممرات البحرية المحيطة بالقارة مكشوف أمام نشاط سوڤييتى يتغلغل فى القارة بجهد يزيد، خصوصا فى القرن الأفريقى، وبالتحديد فى أثيوبيا (وكان نظام «منجستوهيلا مريم» يحكمها وهو لا يخفى هويته الشيوعية). 3 ــ وأوروبا لا تستطيع أن تقبل هذا الانكشاف للممرات البحرية التى تسير عليها ناقلات البترول الغربية. وبما أن فتح قناة السويس أمام ناقلات البترول مازال معلقا، لأنه مرهون باتفاقيات سلام بين مصر وإسرائيل مباشرة، وبين العرب وإسرائيل بطريق غير مباشر ــ إذن فإن الضرورات تفرض الحد من النفوذ السوڤييتى داخل القارة بكل الوسائل. 4 ــ إن فرنسا اهتمت منذ «ديجول» بوجود سياسى فرنسى ومؤثر فى القارة يحفظ مصالح كثيرة، ويحفظ كذلك صلات حضارية لها قيمتها، وذلك ما دعا «ديجول» إلى إنشاء منظمة «الفرانكفونية»، لكن هذه المنظمة قاصرة فى فعلها السياسى على عكس منظمة «الكومنولث»، لأن الأقاليم الإنجليزية من أفريقيا (يقصد الدول الأفريقية التى كانت تخضع للاستعمار البريطانى، والتى اعتمدت اللغة الإنجليزية)، انضمت إلى «الكومنولث» البريطانى (وهو تنظيم اقتصادى)، فى حين أن فرنسا اختارت الثقافة رابطا عن طريق منظمة «الفرانكفونية»، باعتبار اللغة الفرنسية أساسا مشتركا، لكن «الفرانكفونية» غرقت فى الأدب والثقافة، ونسيت الإستراتيچية والسياسة، ربما تحت تأثير «سنجور» (زعيم السنغال)، ويستدرك الرئيس الفرنسى: لا تنس أن «سنجور» شاعر! ـ وإذا كان ذلك، فقد كانت تكفينا عضوية «اليونيسكو» (منظمة الثقافة والعلوم)، دون داعٍ لـ «الفرانكفونية» ــ وسألنى «جيسكار ديستان» إذا كان عندى ما يمنع من مقابلة «ألكسندر دى ميرانش»، مع العلم بأنه مدير المخابرات الخارجية الفرنسية، لأنه الرجل الذى يعرف أكثر من غيره عن الخطر السوڤييتى فى أفريقيا، وطرق التصدى له! ــ (وكانت تلك أول مرة أسمع فيها اسم الرجل أو أعرف شيئا عنه). وقلت «إننى أقابل كل من أستطيع أن أعرف منه جديدا». *** وعلى أى حال فقد انتهت مقابلتنا يومها، بأن قال لى الرئيس «ديستان»: إنه سوف يطلب إلى «ألكسندر»، وهو يقصد الكونت «ألكسندر دى ميرانش» أن يتصل بى فى الفندق الذى أقيم فيه. وكذلك قابلت «دى ميرانش» لأول مرة، ومن المصادفات أننى عرفت منه قرابته (ابن عم) لصديقة قديمة هى الكونتيسة «تيريز دى سان فال» وهى ــ وقتها ــ مديرة النشر فى «فلاماريون» أكبر دور النشر فى فرنسا، وهى تحوز حق نشر كتبى فى اللغة الفرنسية. وعندما جاء «دى ميرانش» إلى لقائى فى فندق «الكريون» (الذى كنت أقيم فيه)، إذا هو يدعونى إلى صالون حجزه فى نفس الفندق لكى نتحدث بعيدا عن الجالسين غيرنا فى صالون «الإمبراطورية» حيث انتظرته، وظهر أن أحد مساعديه رتب ــ حيث حجز ــ شاشة عرض ظهرت عليها خريطة أفريقيا وخطوط طرق الملاحة البحرية حولها، مع بيان لعدد وحمولة ناقلات البترول التى تتقاطر على مسالكها كل يوم. وجلسنا أمام الشاشة الكبيرة، وراح «دى ميرانش» يشرح والخرائط على الشاشة تتغير، وبعض الصور تظهر ومعها لمحات من وثائق وجداول وأرقام، متوافقة مع سياق العرض!! ــ وكان «دى ميرانش» يتدخل بين الحين والآخر بتعليقات فيها التركيز الشديد على أن فرنسا مازالت قوة كبرى، حتى وإن قبلت باستقلال مستعمراتها!! ــ وأن أفريقيا مازالت تهمها (وهى لا تستطيع أن تنسحب منها كما فعلت فى آسيا عقب استقلال «ڤيتنام»). ــ وأن «فرنسا» دولة متوسطية لا تقبل بأى خطر يهدد المتوسط ــ والمتوسط هو «سقف» أفريقيا!! *** وانتهى العرض وراح «دى ميرانش» يتوسع فى الشرح بأن «فرنسا» هى أكبر مستهلك للطاقة فى القارة الأوروبية، وهى لا تملك مباشرة نفوذا على مصادرها فى الخليج، ولذلك فإن حياتها وحياة المجتمع الأوروبى الذى تنتمى إليه معلقة على بتروله، وهى تعتبر نفسها شريكا رئيسيا فى تأمينه، وفى ذلك فإنها تتعاون مع عدد من دول المنطقة، وقد أنشأوا معا «تعاون فعل» (Cooperation D’action). أضاف «دى ميرانش» أنه من حسن الحظ أن بعض القوى المعنية فى الشرق الأوسط دخلت مع فرنسا فى هذا «التعاون فى الفعل»، وأن «فرنسا» هى التى أقنعت أمريكا وإسرائيل بأن لا تدخلا ضمن مجموعته، حتى لا تؤثر شكوك العرب فيهما على صدق «تعاون الفعل»، بل وقع الاتفاق على أن تكون كلاهما ــ الولايات المتحدة وإسرائيل ــ على علم ــ ومن مسافة بما تقوم به المجموعة، وهذا ضرورى حتى لا يحدث صدام بين الخطط فى الظلام. وقال «دى ميرانش»: «إنهم اختاروا للمجموعة عنوان «سفارى» (السفر فى الغابات)، لأن نشاط المجموعة الأصلى فى أفريقيا، وقد اختاروا اسما رومانسيا «بالكود» لا يستطيع تحديد معناه أحد إلا إذا كان طرفا فى اللعبة!! وأضاف «دى ميرانش» أنه من حسن الحظ أن رجالا مثل الملك «الحسن» (فى المغرب)، والملك «فيصل» (فى السعودية)، والشاه «محمد رضا بهلوى» (فى إيران)، والرئيس «السادات» (فى مصر) ــ توفر لديهم بُعد النظر والجسارة لكى يتعاونوا مع فرنسا فى هذه المهمة التى تعنيهم وتؤثر على مصالحهم الحيوية!! واستطرد «دى ميرانش» إلى تحديد المخاطر التى تهدد أفريقيا، بلدا بعد بلد، وكان تركيزه على القرن الأفريقى واضحا، وبعده على الكونجو وأنجولا. وقال «دى ميرانش»: هذا فى الواقع «تعاون فعل» إستراتيچى، يحقق مصالح مشتركة، ولذلك فإن تنفيذه تم بمعاهدة خاصة ومغلقة بين الدول الخمس. وسألته ــ دون تعليق حتى لا أصد تدفقه فى الشرح ــ عما إذا كانت الدول العربية التى وقَّعت على الاتفاق (فى الواقع معاهدة) تعرف أن هناك تنسيقا مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، وكان جوابه دون تردد: «إنهم بالطبع يعرفون، لكننا أعفيناهم جميعا من الحرج، وعهدنا بالتنسيق مع أمريكا إلى «إيران»، ثم إن الولايات المتحدة فى إطار علاقاتها الخاصة مع إسرائيل تتولى إحاطتها علما بما يصح لها أن تعرفه!». *** وكان «دى ميرانش» يظهر اهتماما خاصا بالسعودية، لاعتقاد عنده ــ أفاض فى شرحه ــ بأن الإسلام يجب أن يلعب دورا أساسيا فى حماية النفط، وكان قوله «إنه من حسن الحظ أن أكبر منتج للنفط هو نفسه بيت الأماكن المقدسة لدى المسلمين، و«فرنسا» لا ترى على الإطلاق صداما بين الإسلام وأوروبا، وبالعكس فإن «فرنسا» من أنصار حوار أديان بين الإسلام والغرب، وقد بدأوا بالفعل جهودا مشتركة مع علماء السعودية، وهذه الجهود تلقى تشجيعا من مصر (وكان ذلك صحيحا وإن كان علماء السعودية قد استشعروا الحرج من هذا الحوار، وكان أن أحد مشايخ الأزهر السابقين تحمس لمواصلته فى مصر، وأنشأ فى تلك الجامعة الإسلامية العريقة (الأزهر) مركزا خاصا لهذا الحوار!). كان رأى «دى ميرانش» وقد قارب على نهاية عرضه «أن المفكرين العرب لابد لهم أن يساعدوا على تفاهم حضارى، بين روح الإسلام وروح أوروبا». أضاف أن «مصر» لها جهود سابقة فى هذا المجال منذ «ذهاب نابليون بونابرت» إلى مصر، وصحيح أن جهود مصر السابقة كانت مدفوعة بمطلب التنوير، إلا أن إرث الثقافة لابد أن يؤدى إلى حماية المصالح الحية لأصحابه»!! وكنت أسمع باهتمام متفكرا فى مقدرة الدول الكبرى على عرض مصالحها الدائمة فى ظروف متغيرة، وكيف تغطى فعل حرب خفية فى الواقع بغطاء الثقافة والحضارة ــ وحتى الأديان!! (ثم لقيت «دى ميرانش» مرة ثانية بعد ذلك فى مكتبه، وكان هذه المرة قد أضاف إلى اهتمامه بأفريقيا اهتماما مستجدا بأمريكا الوسطى وبكوبا). *** ومرت سنوات وتغيَّر ساكن قصر «الإليزيه»، وخرج «ديستان» ودخل «ميتران»، وجاء لقائى معه الذى أشرت إليه قبل قليل، والذى تحدَّث فيه بغموض عن «الذين يعرفون مبارك»، وعن مصلحة الدولة Raison D’Etat، وتردَّد فيه اسم «دى ميرانش» أكثر من مرة، وكذلك تصورت أن أحاول لقاءه مرة ثانية، وتوافقت الظروف مع المطالب فإذا بـ«دى ميرانش» نفسه يحاول مقابلتى، وكان وسيطه هذه المرة «ابنة العم» كما يسميها ــ الكونتيسة «تيريز دى سان فال» (مديرة النشر فى مؤسسة «فلاماريون»)، والتى اتصلت بى تقول «إن ابن عمها يرغب فى لقائى، لأنه يريد أن يصحح لى بعض ما نشرته فى كتابى عن الثورة الإيرانية «عودة آية الله» The Return of Ayatollah. وكانت بعض الفصول من الكتاب قد بدأ نشرها فى جريدة «الفيجارو»، تمهيدا لصدوره عن دار «فلاماريون» ــ وكنت فى ذلك الكتاب قد خصصت فصلا كاملا تعرَّض لأول مرة لسر مجموعة «السافارى»، فقد اطلعت على نصوص المعاهدة التى أنشأت المجموعة، وكان اطلاعى عليها فى قصر «نياڤاران»، حيث المقر الرسمى لعمل ومعيشة شاه إيران، وكان «آية الله الخمينى» قد وجَّه بتسهيل اطلاعى على ما أريد من وثائق العصر الذى قامت الثورة الإيرانية لإسقاطه! وكانت وثيقة إنشاء المعاهدة وتوقيعها فى اجتماع خاص عُقد فى «جدة»، وقد نشرت أهم نصوصها فى الكتاب، ومع النصوص أسماء من وقَّعوا عليها نيابة عن رؤسائهم، وكان نشر الأسماء قد أحدث ضجة كبرى ذلك الوقت، فقد كان الموقِّعون المفوضون خمسة: ــ الكونت «دى ميرانش» نفسه (مدير المخابرات الخارجية الفرنسية) ــ عن الرئيس «ديستان». ــ و«كمال أدهم» (مدير المخابرات العامة السعودية ـ عن الملك «فيصل»). ــ والچنرال «أحمد الدليمى» (مدير المخابرات المغربية ــ عن الملك «الحسن»). ــ والچنرال «نعمة الله ناصري» (مدير الساڤاك ــ المخابرات الإيرانية ــ عن الشاه «محمد رضا بهلوى»). ــ ثم الدكتور «أشرف مروان» (مدير مكتب الرئيس للمعلومات ــ عن الرئيس «أنور السادات»). *** والآن كان الموضوع الذى تضايق منه «ألكسندر دى ميرانش» وجاء يطلب تصحيحه، هو ما قلته عما جرى لأحد نوابه، وكيف سُرقت منه حقيبة أوراقه أثناء مروره من مطار «الدار البيضاء» عقب اجتماع سرى فى المغرب، ثم إن هذا الچنرال جرى لومه على أن عملاء سوڤييت (بالطبع ــ ومن غيرهم؟!!) استطاعوا أن يسرقوا حقيبة أوراقه، وفيها أسرار مهمة، وكنت فى الكتاب قد أضفت أن الچنرال الفرنسى المسئول جرى قتله بعد ذلك، وقيل إن ذلك كان عقابه!! وكان ما ضايق الكونت «دى ميرانش» أن ما قلته فى الكتاب قد يوحى بأنه هو «دى ميرانش» ــ رئيسه المباشر ــ مَنْ أصدر الأمر بتصفيته عقابا له، والآن كان «دى ميرانش» يطلب منى أن أضيف توضيحا إلى الطبعة الفرنسية من الكتاب (على الأقل)، وقد عرف من ابنة عمه (الكونتيسة «دى سان فال» ــ مديرة النشر فى «فلاماريون») أنه على وشك الصدور، وإلا فإنه سوف يضطر آسفا إلى رفع قضية «قذف» على «فلاماريون» كناشر للكتاب، وعلىَّ معها كمؤلف له!! وكان «دى ميرانش» فى ذلك الوقت، ومن قبل دخول «فرانسوا ميتران» إلى قصر «الإليزيه» قد اعتزل منصبه! والآن أصبح حرا، وانفكت إلى حد ما عقدة لسانه، بل إن حديثه أصبح أكثر تدفقا وحيوية. *** والتقينا ومعنا فى بداية اللقاء ابنة عمه «تيريز دى سان فال»، وكنا هذه المرة جالسين فى ركن على بركة السباحة فى حديقة فندق «ريتز» فى ميدان «فاندوم» الشهير، بعامود الصلب الذى صنعه «نابليون بونابرت» من المدافع التى غنمها فى معركة «استرليتز»!!ومع أن موعدنا كان العاشرة صباحا، فقد أدهشنى أن «دى ميرانش» وقد سألته إذا كان يريد فنجان قهوة، أنه أجاب بسؤال عما إذا كان يضايقنى أن يطلب كأسا من «الويسكى». وربما بتأثير ذلك الغموض فى إشارة الرئيس «ميتران» قبل أيام إلى أن هناك «عندنا من يعرفون الرئيس المصرى الجديد»، ثم تردد اسم «دى ميرانش» بعد ذلك مرتين على الأقل، أننى سألته مباشرة: ــ يظهر أنك تعرف رئيسنا الجديد، كذلك أحسست من إشارة أثناء لقاء مع الرئيس الفرنسى «ميتران» أول هذا الأسبوع. ونظر إلىَّ «دى ميرانش»، وعيناه تلمعان: ــ طبعا.. طبعا أعرفه، لقيته فى إطار مجموعة «السافارى» التى أذكر أننى حدثتك عنها قبل سنوات. فى البداية: كان «أشرف مروان» هو الذى يمثل الرئيس «السادات» فى المجموعة. وبعد سنتين غاب «أشرف مروان» وحل محله «مبارك»! *** ثم راح «دى ميرانش» يتحدث منطلقا فى الحديث، وربما طمأنه أنه الآن عرف أننى على اتصال برئيسين فرنسيين: «چيسكار ديستان»، والآن «فرانسوا ميتران».وتحدَّث «دى ميرانش» عن نشأة المجموعة، وكيف أنها بدأت فى منتصف السبعينيات، وبعد سقوط الرئيس «ريتشارد نيكسون» بسبب فضيحة «ووترچيت» سنة 1974، وبسببها ــ أيضا ــ فإن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (C.I.A) وهى العملاق الأكبر فى عالم المخابرات تعطَّلت، لأنها أصبحت موضع تحقيقات واسعة فى الكونجرس، بعدما ظهر تورطها فى العمل داخل الولايات المتحدة نفسها، على عكس قانونها ــ ثم زاد أن الرئيس الأمريكى الجديد ــ بعد خروج «نيكسون» من البيت الأبيض ــ وهو الرئيس «جيرالد فورد» قرر هو الآخر إنشاء لجنة خاصة ــ رأسها نائبه «نلسون روكفللر» ــ للتحقيق فى تجاوزات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التى طال لهذه الأسباب تعطلها، خصوصا بعد أن قام الكونجرس بتجميد الاعتمادات المالية المرصودة لها. ويستطرد «دى ميرانش»: «وفى ذلك الوقت وجدنا أننا من المحتم علينا أن نتحرك على مسئوليتنا، ودعونا أصدقاءنا وأصدقاء الولايات المتحدة كى يتعاونوا معنا، وكانت المملكة العربية السعودية جاهزة بالتمويل، وكنتم أنتم فى مصر مستعدين بمعسكرات التدريب، وكان المغرب مستعدا بعناصر بشرية، وكان شاه إيران داعما بكل الوسائل (At large). وكان «أشرف مروان» ممثل مصر، ثم اختفى ــ كما قلت لك ــ وظهر «مبارك» نائب الرئيس. ثم توقف «دى ميرانش» بطلب كأس آخر من الويسكى، ثم استأنف حديثه: ــ «تسألنى عن «مبارك» ــ أعرفه ــ أعرفه طبعا يا صديقى، كان معنا فى جلسات «السافارى»، حيث عقدناها فى «جدة» مرات، وفى «القاهرة» مرات، وفى «طهران» مرات، وفى «المغرب» مرات، لكننا لم نعقد اجتماعات كثيرة فى «فرنسا»، حتى لا تتصور واشنطن أننا نريد هيمنة على المجموعة. كانت الـ C.I.A حساسة جدا، مع أننا كنا نطلعهم على كل شىء، وكانوا يقومون بإطلاع إسرائيل التى طلبت أن تشارك فى نشاطنا، لأن لها موارد مخابراتية لها قيمتها فى أفريقيا، ولكننا اعتذرنا عن طلبها حتى لا تشعر السعودية بالحرج، ولم يكن هناك حرج لدى المصريين ولا لدى المغاربة، فلديهم علاقات مباشرة مع إسرائيل!». وعاد «دى ميرانش» إلى ذِكر «مبارك»: «نعم.. نعم أعرفه، كان معنا لسنوات». وارتكبت خطأ فيما أظن، فقد سألته عن مجال ما كان «مبارك» مهتما به، ويظهر أن السؤال أثار لديه طبائع رجل المخابرات، فقد توقف متحفظا «بأنه لا يستطيع أن يدخل فى تفصيل عمليات بالذات!». وبينما كان لقاؤنا يقارب نهايته، أضاف «دى ميرانش» لمحة أخرى عن «مبارك» ـ فقد قال: «أنه «تابَع» «مبارك» منذ أن ظهرت صورته لأول مرة «أمامهم» فى أجواء صفقة طائرات «الميراچ» التى عقدتها ليبيا مع فرنسا سنة 1971، وهى صفقة كبيرة حجمها 106 طائرات». وقال «دى ميرانش»: «كنا نعرف أن ليبيا تعقد هذه الصفقة لصالح مصر ولمساعدتها فى حرب 1973، ولذلك رحنا نراقب باهتمام، وفى الواقع فقد رصدنا وفد المفاوضات الذى بدأ التفاوض فى الصفقة مع شركة «طومسون» وكانوا جميعا ضباطا من سلاح الطيران المصرى «أعطوهم» جوازات سفر ليبية لإقناعنا أنهم ليبيون، لكننا عرفنا حقيقة أمرهم» ــ أضاف «ذلك لم يعد الآن سرا». واستطرد «دى ميرانش»: «فى هذا الوقت لمحت «مبارك» لأول مرة، فقد حدث خلاف بين بعض الذين شاركوا فى مفاوضات عقد الصفقة، وكانوا قد تركوا سلاح الطيران المصرى وكوَّنوا شركة بينهم، ثم اختلفوا واشتد خلافهم لأسباب، وظهر «مبارك» يصالحهم مع بعضهم بالحرص على علاقاتهم معا، وهم فى الأصل من ضباطه، وكان علينا أن نرصد كل شىء، لأن الصفقة كلها أحاطت بها ظروف غير عادية!! وأحسست أن «دى ميرانش» عاوده حذر رجل المخابرات القديم، فتوقفت ولم أشأ أن أعلِّق بكلمة!! *** ولم أزد وبدا لى أنه لن يقول أكثر مما قال، ومع ذلك فإن «دى ميرانش» راح يردد اسم «مبارك» ويضيف وبنبرة دهشة لم يستطع إخفاءها، يقول:«هل ترى الأقدار؟! أنا أجد نفسى الآن فى التقاعد، وزميلى السابق فى «مجموعة السافارى» على رئاسة الدولة المصرية!!». ويضيف: و«أنا ختمت حياتى العملية فى الظل، وهو الآن يبدأ صفحة جديدة تحت الأضواء الباهرة!!». ويزيد بصيغة التعجب: «مقادير.. مقادير يا عزيزى!!». *** ومن الغريب بعدها ــ وهذه إضافة بالزيادة ــ أن التفاصيل سعت إلىَّ بعد ذلك، وبنفسها، فقد حدث فى سبتمبر 2008 أننى كنت فى «باريس»، والتقيت مصادفة فى صالة فندق «بريستول» بالسيد «عبد السلام جلود»، الذى كان رئيسا لوزراء ليبيا بعد ثورة سبتمبر 1969 (وكان «جلود» فى زمانه هو الرجل الثانى فى قيادة الثورة بعد «معمر القذافى»)، وكنت فى صالة «البريستول» أنتظر ضيفا موعده بعد نصف ساعة، ودعوت «جلود» للجلوس فى الحديقة الداخلية للفندق، وراح «جلود» يحكى، وتطرَّق إلى صفقة «الميراچ» مع فرنسا، مؤكدا أن قيمتها كانت 4 مليارات دولار، ثم استطرد فى التفاصيل، ومن حسن الحظ أن هذا الجزء من الحديث جرى أمام شاهد هو ضيفى الذى كنت أنتظره أصلا، وهو الدكتور «غسان سلامة» (المفكر اللامع ووزير الثقافة اللبنانى الأسبق، وهو الآن أستاذ فى جامعة «باريس»)، ودعوته للجلوس مع «عبدالسلام جلود» وسألنى «جلود» بعد أن قدمت إليه ضيفى همسا: «هل تثق فيه»؟!! – وأكدت له ثقتى فى «غسان سلامة»، واستأنف «جلود» واستفاض فى الحديث، لكنى لا أستطيع أن أنقل كثيرا مما سمعت، فليس لدىَّ مصدر ثانٍ يؤكد ما رواه، وفى أصول المهنة كما أعرفها أننى إذا لم أشهد بنفسى وقائع ما أتحدث فيه، فمن الضرورى تأكيدها قبل نشرها بشهادة مصدر ثانٍ، ولم أجد مصدرا ثانيا لما سمعت وقتها فى صالون فندق «البريستول»، وعلى أية حال فإن «عبد السلام جلود» يستطيع تفصيل روايته إذا شاء!! |
|
#14
|
||||
|
||||
|
جزاك الله خيرا
__________________
 |
|
#15
|
||||
|
||||
|
مبارك تعاون مع المخابرات الامريكية والاسرائيلية وتفاصيل عن صفقة الطائرات واصل الكاتب محمد حسنين هيكل كشفه عن اسرار النظام السابق في كتابه "مبارك وزمانه ..من المنصة الي الميدان " التي تنشرها جريدة الشروق حيث كشف هيكل في الحلقة السادسة من كتابه أن الرئيس الفرنسى الأسبق كان يعرف مبارك، عن طريق رجال المخابرات الفرنسية، الذين تباعوا تحركات الرئيس السابق، وقت أن كان نائبا للرئيس الراحل أنور السادات. وحكى هيكل أنه تحدث ذات يوم مع "دى ميرانش" مدير المخابرات الفرنسية فى الثمانينات، وسأله عن مبارك، فكان رد "ميرانش" سريعًا بأنه يعرف مبارك عن قرب، ووقتها قال لـ"هيكل": "أتذكر مبارك وأتباعه منذ أن ظهرت صورته أمام الفرنسيين لأول مرة فى أجواء صفقة طائرت الميراج التى عقدتها ليبيا مع فرنسا عام 1971، وكانت صفقة كبيرة حجمها 106 طائرات". وحين حاول "ميرانش" تفسير كواليس الصفقة لـ"هيكل" قال له: "كنا نعرف أن ليبيا تعقد هذه الصفقة لصالح مصر، لمساعدتها فى حرب أكتوبر عام 1973، ولذلك رحنا نراقب باهتمام، وفى الواقع رصدنا وفد المفاوضات الذى بدأ التفاوض فى الصفقة مع شركة طومسون، وكانوا جميعا ضباطا من سلاح الطيران المصرى، أعطوهم جوازات سفر ليبية، لإقناعهم بأنهم ليبيون، لكننا عرفنا حقيقة أمرهم، ولذلك لم يعد الآن سرًا". أضاف "ميرانش" فى محض تفسيره لكواليس صفقة الطائرات، وفقًا لما ذكره هيكل فى كتابه: "فى هذا الوقت لمحت مبارك، لأول مرة، فقد حدث خلافًا بين بعض الذين شاركوا فى مفاوضات عقد الصفقة، وكانوا قد تركوا سلاح الطيران المصرى، وكونوا شركة بينهم، ثم اختلفوا واشتد خلافهم، وظهر مبارك يصالحهم مع بعضهم، بالحرص على علاقاتهم معًا، وهم في الأصل من ضباطه، وكان علينا أن نرصد كل شئ لأن الصفقة كلها أحاطت بها ظروف غير عادية". وبالمصادفة، كان هيكل فى رحلة سفر إلى فرنسا، فى شهر سبتمبر عام 2008، والتقى عبد السلام جلود، الذى كان رئيسًا لوزراء ليبيا بعد سبتمبر عام 1969، كما كان جلود فى زمانه، هو الرجل الثانى فى قيادة الثورة الليبية بعد العقيد معمر القذافى وذكر "جلود" خلال هذا اللقاء أن قيمة صفقة قيمة الميراج مع فرنسا كانت 4 مليارات دولار. وحصل هيكل من "دى ميرانش" على معلومات تفيد أن الولايات المتحدة وإسرائيل –وقت حكم السادات لمصر- كوّنوا مجموعة حملت عنوان "سفارى" أى (السفر فى الغابات) وكان نشاط هذه المجموعة الأصلى فى إفريقيا، وأن الملك "الحسن" فى المغرب، والملك "فيصل" فى السعودية، والشاه محمد رضا بهلوى فى إيران، وأنور السادات فى مصر، توفرت لديهم الجسارة لكى يتعاونوا مع فرنسا فى هذه المهمة، حيث كان يربط الدول الخمس "المغرب والسعودية وإيران ومصر وفرنسا" معاهدة مغلقة، وكان مبارك أحد الأشخاص الذين شاركوا فى هذه المعاهدة التى تم تسميتها بكلمة "كود" ولا يستطيع أحد تحديد معنى هذا الكود إلا إذا كان "طرفًا فى اللعبة"، وكان مبارك أحد المشاركين فيها. http://www.almogaz.com/politics/news/2012/01/26/166545 |
 |
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:47 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.











 العرض العادي
العرض العادي

